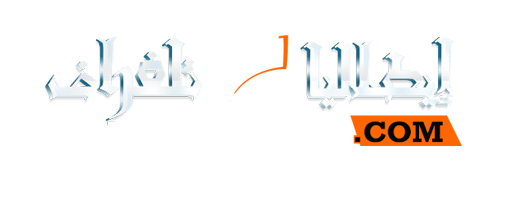مروان قبلان
كاتب وباحث سوري
كان يُفترض بأول انتخابات لمجلس الشعب السوري (البرلمان) بعد سقوط الأسد، ونظامه، أن تكون نقطة تحوّل في حياة السوريين السياسية، يمارسون فيها بإرادتهم الحرّة حقهم الأصيل في الترشح، واختيار ممثليهم، بما يجسّد حالة انتقالية حقيقية من عهد الاستبداد إلى عهد الحرية. هذا لم يحصُل، للأسف، إذ جرى ترتيب العملية الانتخابية و”توضيبها” بطريقةٍ لا تترك مجالًا لأي نقاش، رقابة، أو مساءلة، حقيقية تحت قبة البرلمان. تقول الإدارة الجديدة أن الظروف لا تسمح بتنظيم انتخابات عامة، بمستوى الطموح، نتيجة الدمار، والتهجير، وانزياح كتل سكّانية بأكملها، وعدم وجود سجلات للناخبين، واستمرار وجود نحو مليوني سوري في مخيمات داخل البلاد، عدا عن الخارج. هذا كله صحيح، ولا جدال فيه، لكن كان الأجدر، لهذا السبب تماماً، بدلاً من التعيين المباشر وغير المباشر، تأجيل الانتخابات ريثما تتوفّر ظروفُ إجرائها، خلال عام أو عامين، ربما، طالما أن الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) يحدّد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، علماً أنه لا توجد ضغوط فعلية، سواء من الداخل أو الخارج، لإجراء انتخابات يتفق الجميع على صعوبة تنظيمها في الظروف الراهنة. كان يمكن، فوق ذلك، استخدام الفسحة الزمنية المقترحة لإطلاق حياة سياسية طبيعية، تبلغ ذروتها بالانتخاب وتشكيل البرلمان. ما حصل عكس ذلك تماماً، إذ جرى تشكيل البرلمان في غياب كامل لأيٍّ من مظاهر الحياة السياسية، فلا تيارات ولا أحزاب، بحكم عدم وجود قانون ينظّم عملها، ولا توجد، فوق ذلك، نقاشات جدّية حول خطط المرشّحين وبرامجهم، ولا حتى نقاش سياسي عام، خلا حملات السب والشتم التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي. أما القول بالحاجة إلى مجلس تشريعي لإقرار القوانين وإصلاح الموجود منها فيمكن دحضه بسهولة، ذلك أن السلطة التنفيذية تمارس منذ لحظة استلامها السلطة فعلياً مهامّ السلطة التشريعية، في خرقٍ واضحٍ لنص الإعلان الدستوري الذي وضعته بنفسها، عدا عن أنها هي من يعيّن السلطة التشريعية ويسمّي كل شخص فيها.
لكن هذا كله على أهميّته لا يمثل النقطة المحورية التي تستوقفنا، بل جرت الانتخابات في غياب إجماع وطني عليها، وهي تمثل، لذلك، خطوة إضافية في مسار ما فتئ، منذ انطلاقته، يعزّز انقسامات السوريين، يؤجّج صراعاتهم، ويهمّش الجزء الأكبر منهم، رغم ادّعاء تمثيل أغلبيتهم، وتصرّ، مع ذلك، الإدارة الجديدة على الاستمرار فيه، رغم كل الاعتراضات عليه. بدأ هذا المسار بـ “مؤتمر النصر” في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي اقتصرت الدعوة فيه على الفصائل العسكرية، مروراً بـ “مؤتمر الحوار الوطني” الشكلي، الذي جرى ترتيبه على عجل، في 25 فبراير/ شباط، لإصدار بيانٍ مكتوب سلفاً، يرسم مسار “الانتقال” العتيد ويمحضه شيئاً من الشرعية، ثم الإعلان الدستوري، في 13 مارس/ آذار، الذي حدّدت الإدارة الجديدة فيه السلطات التي تريدها لنفسها، قبل أن تعهد بصياغته إلى مجموعة من الخبراء القانونيين، وصولاً إلى تشكيل “الحكومة المؤقتة”، نهاية مارس، تحت مسمّى “حكومة تكنوقراط”، حتى لا تحصل مشاورات بشأنها، وأخيراً مجلس الشعب الذي جرى تشكيله، رغم اللغط، واستبعاد ثلاث محافظات سورية، وفي غياب معايير واضحة لاختيار أعضاء الهيئات الناخبة، ما سبّب انقساماً وتناحراً حتى بين أبناء الحي الواحد. المحطّة الأخيرة في هذا المسار، كما يبدو، هي كتابة “الدستور الدائم”، والتي يتوقّع أن تجرى بالطريقة نفسها، بحيث لا نصل إلى الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام (8 ديسمبر) إلا وقد أنهت الإدارة الجديدة ترتيبات المرحلة الانتقالية بالكامل، وهذا ما قصده الرئيس أحمد الشرع، في الكلمة القصيرة التي ألقاها في زيارته إلى المركز الانتخابي في المكتبة الوطنية، بقوله: “استطعنا خلال بضعة أشهر، أن نحقق إنجازاً”، يسجل للسوريين الذين “أبدعوا في إنجازاتهم على مر التاريخ”. الرئيس الشرع محقٌّ تماماً، فما حصل إنجاز لم يسبقنا إليه أحد. فرغم التحدّيات، تمكّنت الإدارة الجديدة من “حرق” كل المراحل في سعيها إلى الإمساك بمفاصل السلطة، حتى إنها لن تحتاج ولا إلى ربع فترة السنوات الخمس التي حدّدتها لنفسها في الإعلان الدستوري، بغض النظر عن الثمن المترتّب على ذلك، وانعكاساته على وحدة البلد، واستقراره السياسي والأمني وتعافيه الاقتصادي. لكن هذا كله لن يهم، إذا لم يكن القصد أن يكون الحكم رضائيّاً، ومستنداً إلى توافق وطني، حول الدولة، ونظامها السياسي وكيفية تداول السلطة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف