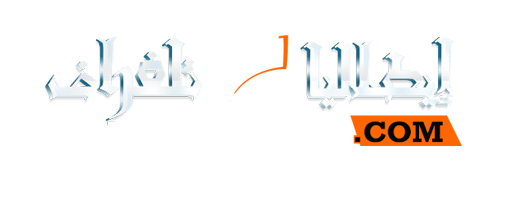*معتز الخطيب
أوضحت في مقالات سابقة أن لدينا أدبيات إسلامية ثرية جدًّا عن الطاعون وما يتصل بالأوبئة، وعلى الرغم من تشعب المناقشات الإسلامية في مسألة الطاعون، يمكن القول إنها تمحورت حول موضوع رئيس هو العدوى التي شغلت الأطباء والفقهاء والمتكلمين وعامة الناس بخاصة في ظل انتشار الطاعون الذي كان يأتي على نحو منتظم ومتكرر.
والعدوى موضوع تتقاطع فيه مجالات عدة كالطب والفقه والكلام والأخلاق، ويعكس التوتر بين النص والتجربة، وبين الطب والشرع، كما يوضح تعقيدات العلاقة بين الكلامي والفقهي والأخلاقي في الأزمنة الكلاسيكية، وقد سبق لي أن عالجت طرفًا من هذا في دراسة منشورة في مجلة “تبين”.
وقد استأثر النقاش الكلامي بنصيب كبير من النقاشات الكلاسيكية حول العدوى؛ إذ إنه يرجع إلى ركن الإيمان بالقدر، ويثير إشكال العلاقة بين التصورات الكلامية من جهة، والأحكام الفقهية العملية من جهة أخرى، خصوصًا أنه نشأ لدى العلماء في أزمنة الطاعون تعارض بين أصلين اثنين:
الأول: التوكل والتسليم لله تعالى، وهو فرع عن الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان.
والثاني: الحيطة والحذر عبر الأخذ بالأسباب المادية لصيانة النفس من الوباء وحفظ الحياة.
يتصل الأصل الأول بمنحى كلامي وصوفي أيضًا يتعلق بتصحيح التصورات وفضائل الذات، وهو ما أسميته باللاهوت العملي الذي يتصل بمسائل دينية عقدية، وأخروية تتصل بالعلاقة مع الله، ويتصل الأصل الثاني بمسائل فقهية وأخلاقية تتعلق بشكل الفعل الواجب في زمن الأوبئة تجاه الذات وتجاه الآخرين.
فالتوكل والتسليم لله تعالى سيقود إلى نمط من الممارسة الإيمانية، وهو ما عبّر عنه بعض المتصوفة بالسكون تحت الأقدار الإلهية، والتخلي عن الاختيار الإنساني. ونفي الأسباب أو نفي تأثيرها يطرح السؤال عن جدواها من جهة كما يحمل على القعود عن البحث في كيفية حصولها وفهم قوانين ما يجري في الطبيعة من جهة أخرى، وكل هذا سيقود الفقيه أو المحدث إلى وضع تأويلات تناسب التصور الكلامي لنصوص الحديث التي يرد فيها النهي عن الخروج من أرض الطاعون أو النهي عن الدخول إليها.
ولأن المتابع للنقاشات الكلاسيكية الشديدة حول العدوى قد يتيه في تفاصيلها وتشعباتها أودّ أن ألخص هنا آراء العلماء في العدوى في قولين اثنين:
الأول: مذهب من ينفي العدوى جملة وتفصيلًا؛ تمسكًا بظاهر حديث “لا عدوى”، بحيث يعدّه أصلًا يتم تأويل باقي الأحاديث لتتفق معه، رغم أن حديث “لا عدوى” نفسه تَرِد فيه عبارة “وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد” وهي تشير إلى وجود العدوى ظاهرًا على الأقل، ولكن بعض العلماء مايز بين الأمراض ففرق بين الطاعون والجذام في موضوع العدوى، ورأى أن للطاعون خصوصية لا توجد في غيره وهي مسألة ساعد عليها غموضه وعدم توصل الطب إلى علاج فعال له.
الثاني: مذهب من أثبت العدوى من حيث الجملة، ولكنهم اختلفوا في التفاصيل، وهنا يمكننا رصد 3 أقوال ترجع إلى المذاهب الكلامية في تأثير الأسباب وخلق الأفعال وهي كالآتي:
1. مذهب الطبائعيين الذين يرون إثبات العدوى استقلالًا، وأن الأسباب لا تنفك عن التأثير بذاتها، وهو المعنى الحقيقي لمصطلح العدوى كما فهمه علماء المسلمين النافون وجود العدوى.
2. مذهب طائفة من العلماء وهو إثبات التأثير للأسباب، ولكنه تأثير غير ذاتي أو غير مستقل، ويمكن التعبير عن هذا بأن الأثر يقع بالسبب لا عنده.
3. مذهب طائفة من العلماء في أن الاقتران بين السبب والمسبّب هو مجرد اقتران عادي، ويُعبَّر عنه غالبًا بأن المسبَّب يحصل عند السبب لا به، وذلك لنفي التأثير عن الأسباب، وهو الموقف الأشعري التقليدي من الأسباب عامة.
وفي رأيي أن وجه الإشكال في مسألة العدوى يرجع إلى أمرين:
أولهما: أن المشيئة أو القدرة الإلهية في تصور المتكلمين المسلمين هي أحد تجليات مفهوم توحيد الله تعالى وإثبات الخالقية له وحده، ومن ثم فإثبات الفاعلية للأسباب وأنها مؤثرة من شأنه أن يُخلّ بمفهوم التوحيد، ولذلك بالغوا في نفي التأثير وإثبات الفاعلية والخالقية لله وحده؛ طلبًا لكمال التوحيد.
ثانيهما: أن المشاهدات تُثبت أن تأثير الأسباب ليس مطّردًا ولا حتميًّا، فقد يتخلف التأثير عن السبب كما شهده هؤلاء العلماء أنفسهم في الطواعين.
ولكن المتأمل لأدبيات الطاعون وتفاصيل النقاشات المختلفة حول العدوى يصل إلى قناعة بأن الجدل حولها كان متنوعًا ومركبًا، ولا يمكن اختزاله في ثنائيات بسيطة مثل: العقل أو التجربة في مقابل النص، أو أن المسألة كانت بين طرف يرى الجمود على المنقولات والظاهر في مقابل طرف ينحو منحى علميًّا تجريبيًّا لفهم ما يجري، أو يلجأ إلى تأويل مقاصدي. فقد انطوت النقاشات الكلامية والطبية على أبعاد قيمية أيضًا جرت فيها المفاضلة ين قيم مختلفة ومتعارضة في الوقت نفسه.
لنتأمل مثلًا 3 مواقف مختلفة من العدوى: فالطبيب والعالم أحمد بن خاتمة (ت770هـ) والطبيب والأديب والعالم لسان الدين بن الخطيب (ت776هـ) حاولا إثبات أن الطاعون مُعدٍ وأنه سبب مؤثر في نقل المرض من شخص إلى آخر مستخدمين حججًا ووسائل تجريبية. أما الفقيه المالكي أبو سعيد بن لب (ت782هـ) فقد نفى التأثير السببي، ولكنه في الوقت نفسه أثبت وجود الاقتران العادي بين السبب والمسبَّب على طريقة الأشاعرة. في حين إن الصوفي ابن عجيبة (ت1224هـ) نفى التأثير عن الأسباب كلية، ودعا الناس إلى الاستسلام للأقدار الإلهية.
تتورط القراءة التقليدية والسهلة لمثل هذه الوقائع في الانحياز إلى موقف المثبتين للعدوى لأنه موقف علمي في مقابل المواقف الأخرى التي تبدو ظاهرية أو سلبية، ومناقضة لما ثبت من وجود العدوى في ما بعد، ولكن النقاشات الكلاسيكية كانت أشد تركيبًا وأعمق من هذا الاختزال؛ إذ إن الطاعون كان في حينه مسألة غامضة، ولم يُثبت الطب في الأزمنة الكلاسيكية فاعليته في معالجته أو الوقوف الدقيق على أسبابه، ومن ثم لجأ العلماء إلى نصوص الحديث النبوي لتفسيره وعدّه حالة دينية خاصة وليس مجرد ظاهرة طبيعية، كما أنهم نظروا إلى تأثيراته والتأثيرات الناجمة عن القول بالعدوى في المجتمعات التقليدية التي لم تكن مؤهلة لمجابهة أوبئة بذلك الحجم وقد كانت تجتاح العالم القديم مُخلّفة كثيرا من الضحايا.
حاول الأطباء المتشرعون أن يجدوا حلًّا وسطًا بين القول بمذهب الطبائعيين الذين أثبتوا تأثيرًا ذاتيًّا ومستقلا للأسباب (فالمرض مُعدٍ بطبعه)، وبين القول بمجرد الاقتران العادي غير السببي؛ خصوصًا أن تأملاتهم ومشاهداتهم وخبرتهم الطبية أوصلتهم إلى نتائج مختلفة، ومن هنا أثبتوا السببية ولكنهم رأوا أن تأثير الأسباب غير مستقل ولا طبعي، وإنما هو بإرادة الخالق ومن صنعه، و”عادة غالبة أجراها الله تعالى”، وأن انتقال المرض إنما يجري بفضل خصائص تقوم في المرض من جهة، وخصائص تقوم في الشخص الذي ينتقل إليه المرض من جهة أخرى (وهي الاستعداد أو عدمه، أي ما نسميه اليوم المناعة).
ومن الناحية الدينية قدموا فهمًا متوافقًا مع المعطيات العلمية المتوفرة في زمنهم عبر القول إن الفعل لله تعالى، ولكن فعله سبحانه إنما يجري وفق قوانين طبيعية، وهو ما عبر عنه ابن خاتمة بالقول إن “الفعل في الأول والثاني للحقّ جلّ جلاله؛ خالق كل شيء؛ نفيًا للتوليد الذي يذهب إليه أهل الضّلال، وإبطالًا للعدوى التي كانت تعتقدها العرب في الجاهلية، وإعلانا بالحقّ الذي قام عليه شاهد الوجود”، فقد رأى أن الاجتهاد في فهم ما يجري والأخذ بالأسباب يتسق تمامًا مع مفهوم العبودية الحقة لله تعالى.
وبعيدًا عن تفاصيل هذا الموقف، يمكن القول إن أولوية ابن خاتمة وابن الخطيب كانت تتجه إلى حفظ نفوس الأفراد، وصيانتها بالوقاية والتحوط عن أن يُزهقها المرض المنتقل بالعدوى، وهي قيمة تنسجم مع طبيعة ومجال عملهما طبيبين يتعاطيان معالجة الناس ويريان أن عليهما مسؤولية أخلاقية بهذا الخصوص، وخاصة في زمن الوباء.
أما الفقيه ابن لب الذي كان مرجعًا للفتوى في زمنه، فقد استشعر مسؤولياته من منظور مختلف عن الأطباء، ولذلك حاول أن يقدم رؤية توائم بين اعتبارات عدة، فحذر من ترك العيادة والتمريض والقيام بمؤونة المطعونين، وكان إلى ذلك مهجوسًا باعتبارات أخلاقية واجتماعية وكلامية أيضًا، خصوصًا أن السؤال المطروح عليه كان عن فرار الناس بعضهم من بعض أثناء الوباء وإهمال بعضهم بعضا من دون معين ولا ممرّض بل كان حتى أفراد الأسرة الواحدة يهجر بعضهم بعضًا، وهو سؤال لم يلتفت إليه الطبيب القائل بالعدوى لأنه لم يكن يعالج توابع إثبات العدوى في ظل غياب وسائل طبية منتظمة وقابلة للتعميم في حال القول بإثبات العدوى (سياسات وقائية للصحة العامة).
فإذا كان الطبيب مهجوسًا بسؤال الوقاية والحفاظ على الصحة العامة (من دون توفر إطار مؤسسي وتقني لذلك)، فإن الفقيه كان مهجوسًا بسؤال الحفاظ على النسيج الاجتماعي ورعاية الواجبات الاجتماعية والأخلاقية التي تصون تماسك المجتمع وعلاقات أفراده بعضهم ببعض، ومن هنا أكد ابن لب أن يعامل المسلم الناس في نفسه بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتصور نفسه مكان المصاب بالطاعون فكيف يكون حاله إذا نُبذ وهُجر ومات عطشًا وجوعًا وبلا غُسل “حسب ذلك المذهب في ذلك المرض”؟
ومع ذلك لم ينف ابن لب نفيًا حاسمًا حقيقة انتقال المرض من شخص إلى آخر، ولكنه قيد ذلك باعتقاد أن التأثير إنما هو من الله تعالى (أي إن المرض بذاته لا يؤثر استقلالًا وذلك لينفي مذهب الطبائعيين)، وقيده بأن العمل على شاكلة ذلك “إنما هو ما لم يُؤَدّ إلى تعطيل الفروض وتضييع الحقوق وسدّ أبواب المرافق والمصالح على المرضى”، وهو ما يؤكد منزعه الاجتماعي الأخلاقي الذي أطّر رؤيته الكلامية والفقهية معًا.
والآن نأتي إلى الصوفي ابن عجيبة الذي سخر من لجوء السلطة المحلية في تطوان في مغرب القرن الـ18 إلى إغلاق أبواب المدينة تَحَفظًا من العدوى، لأنه كان يرى أن “الموت والحياة بيد الله ولا تأثير لشيء من الأسباب في الموت وغيره، بل الأمر لله”، وكان يقول لأصحابه “من أراد تربية اليقين وتعلم القوة والشجاعة فليذهب إلى محلها متوكلًا على الله”، وذلك أن “الواجب على العبد أن يسكن تحت مجاري الأقدار وينظر ما يفعله الواحد القهار”. كان ابن عجيبة حريصًا على صيانة عقائد الناس وصرفهم عن التعلق بالأسباب وكأنها كل شيء وكأن فعلها طبعي ومستقل عن الإرادة الإلهية، وينسجم توجه ابن عجيبة مع التوجه الذي ساد لدى مانعي الحجر الصحي كما نجد في بعض كتابات القرن الـ19 في مواجهة هذه التقنية الطبية التي جاء بها الأوروبيون (فقد كانت لها أبعاد سياسية واقتصادية أيضًا).
تؤكد المعطيات السابقة أمورا عدة:
الأول: أن مفهوم العدوى كان مفهومًا إشكاليًّا في أزمنة الطاعون، وهنا يمكن أن نميز بين دلالتين مركزيتين:
انتقال المرض من شخص إلى آخر، وهذا كان مشاهدًا ولم يكن يسمى عدوى في تصور علماء المسلمين، وقد رأينا كيف أن ابن لب لم ينف هذا قطعًا وإنما قيده بناء على مخاوف من تمادي العامة فيه.
إثبات التأثير المستقل للأسباب وأنها فاعلة بنفسها مطلقًا، وأن الطاعون بذاته معدٍ، وهو التصور الذي جزم الفقيه التونسي محمد الرصاع (ت894هـ) بأنه لم يقل به أحد من أهل الإسلام.
الثاني: أن الجدل حول العدوى لم يكن بمعزل عن اعتبارات قيمية دينية وأخلاقية، ولكن المفاضلة بين القيم المتعارضة كانت تتأثر بـ3 أمور:
الخلفية العلمية، ومنظور كل عالم؛ خاصة أن الطاعون كان مرضًا غامضًا ولم ينجح الطب الكلاسيكي لا في فهمه فهمًا متماسكًا ولا في معالجته، الأمر الذي أفسح المجال للتفسيرات الدينية والعودة إلى النصوص الحديثية لتفسيره.
الاستناد إلى نصوص الحديث النبوي حتى من قبل الأطباء، والعودة إلى النصوص مسألة تأويلية خاصة أن فيها نصوصًا متعارضة، وذلك أوجد مجالًا خصبًا للتأويل والتنوع.
أن التجربة كانت مستند العلماء والأطباء معًا، إلا أن كيفية استناد العلماء إلى التجربة لم تكن بطريقة علمية مباشرة، وإنما اكتفوا فقط بالمشاهدات والحكايات، وذلك على خلاف الأطباء الذين تتبعوا التجارب تتبعًا مباشرًا وحللوها بوسائلهم في زمنهم، ولكن على أي حال كان ثمة في زمنهم وقائع تحيل إلى وجود عدوى، كما كان هناك أيضًا وقائع أخرى تحيل إلى عدم اطّراد العدوى، ولم يكن التفسير الطبي مقنعًا بما يكفي لتعميم أحكامه أو لفهم أسباب وقوعها مرة وتخلفها أخرى؛ رغم تشابه الوقائع في الظاهر.
وإذا ما تجاوزنا ظاهر النقاشات الكلامية، سنجد أن النقاش يدور حول 3 منظورات قيمية مختلفة؛ من يرى أن القيمة المركزية هي حفظ النفس، ومن يرى أن القيمة المركزية هي حفظ النسيج الاجتماعي وصيانته عن التفكك في زمن الأوبئة، ومن يرى أن القيمة المركزية هي لصيانة نقاء التوحيد وسلامة المعتقد خصوصًا في زمن الأوبئة التي تشعر بدنوّ الأجل والانتقال إلى الحياة الحقيقية التي تستوجب فضائل خاصة تظهر في سلوك ما قبل الموت، ومن ثم فإن أولوية الحسابات الأخروية يجب أن تهيمن على الحسابات المادية.
لم نشهد في ظل كورونا مثل هذه النقاشات الكلامية حول العدوى، على الرغم من كل الجدل الذي أثير بشأن آثار كورونا (منع الجمع والجماعات، وترك بعض الشعائر والعادات، وغير ذلك)، فلم نشهد أي فتوى تنحو منحى نفي العدوى أو تستعيد النقاشات القديمة. وعلى الرغم من وجود فتاوى هامشية تتحدث عن تحريم لقاح بعينه؛ فإن اعتراضها لم يكن يستند إلى أسباب كلامية بل إلى أسباب فقهية ترجع إلى وجود عناصر غير حلال في اللقاح المعين. أي ليس لديها موقف ضد اللقاح عموما بل ضد لقاح بعينه، وهذا أمر يعكس ما أثبته في دراستي المشار إليها في مطلع هذا المقال في الانتقال “من اللاهوت العملي إلى الأخلاقيات التطبيقية”. فمنتقدو اللقاح اليوم في العالم (anti-vaccination) إنما يستندون إلى معطيات سياسية واقتصادية تتصل بالهمينة والرأسمالية وفقدان الثقة في السلطات السياسية الراعية للسياسات الصحية وليس إلى أسباب كلامية دينية (رغم وجود أصوات هامشية جدًّا عالجتها في مقال سابق).
ويبدو لي أن التسليم بسلطة العلم وفعاليته، خاصة مع تطور علم الأوبئة واللقاحات، أمرٌ بات مسلّمًا، وهو ما أسهم في إيجاد تصور أكثر هدوءًا للعلاقة بين فعل الله وفعل الإنسان في الكون، بعيدًا عن التوترات التي كانت سائدة قديمًا.
*أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة