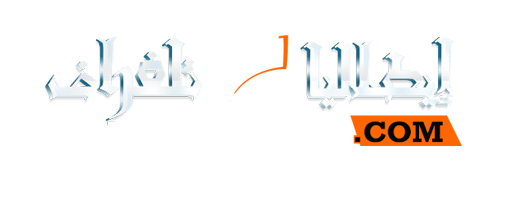جمال الطاهر
باحث وإعلامي تونسي في مونتريال – كندا.
في تونس، وبعد أكثر من ست سنوات من وصول قيس سعيّد إلى سدة الحكم، منها أكثر من أربع سنوات من حكم مطلق منذ 21 يوليو/تموز 2021، يبدو أن البلاد تغرق في أزمتين متكاملتين: الأولى أيديولوجية وسياسية، والأخرى بنيوية واقتصادية واجتماعية.
الآمال التي أثارها سعيد قبيل توليه المنصب تلاشت، والمشهد اليوم لا يوحي بخارطة طريق واضحة للخروج من مأزق موروث فحسب، بل بإحاطة نظام حكم لا يعرَف له أفق.
شكلت الأزمة البيئية والكيميائية في قابس نموذجا صارخا على عجز منظومة الحكم عن معالجة القضايا الحقيقية التي تمس حياة التونسيين اليومية.
فالمأساة التي يعيشها أهالي الجهة منذ عقود بسبب التلوث الصناعي، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، كشفت محدودية الدولة في تقديم حلول جذرية، بل وانعدام الإرادة السياسية لتغيير واقع بيئي كارثي أصبح يهدد الحق في الحياة والصحة.
بدل أن يتحول الملف إلى أولوية وطنية، قابلت السلطة تحركات الأهالي واحتجاجاتهم بمزيد من القمع والملاحقات الأمنية، في مشهد يجسد التناقض الفاضح بين الخطاب الشعبوي للرئيس، القائل إن “الشعب يريد ويعرف ما يريد”، وبين ممارساته السلطوية التي تقصي الشعب ذاته حين يعبر عن إرادته خارج الأطر التي يرسمها النظام.
لم تعد أزمة قابس بيئية فحسب، بل تحولت إلى رمز لانهيار العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ومرآة لعجز السلطة عن مواجهة الأزمات العميقة التي تنخر البلاد.
أولا: أزمة الرؤية
من أكثر المشكلات الجوهرية التي يعانيها نظام سعيد، قصور في تقدير المسائل الهامة وفهم أبعاد المجتمع التونسي الحقيقية. فالحكم ليس مجرد إدارة للإدارة، بل قدرة على تسجيل الأولويات، فهم الواقع، تفسيره، ثم التصرف.
ولكن ما نلاحظه في الأداء الحكومي هو خيبات متكررة في هذا المجال: ملفات كبرى تدار بارتجال، معالجة لمسائل ذات علاقة بحياة الناس اليومية (البطالة، الفقر، الخدمات العمومية، البيئة…) من دون خارطة واضحة، ومن دون أن تبدو اليد الحاكمة قادرة على استشراف ما سيأتي.
وفي هذا السياق، فإن ما تكشّف من إدارة قضية المجمع الكيميائي في قابس (أو بالأحرى ما عرف بتداعياتها البيئية والاجتماعية)، يبدو دليلا إضافيا على أن النظام لا يحسن قراءة الواقع على مستوى محلي، ثم لا يملك أدوات التدبر المناسبة، ولا خطابا يبعث الثقة، ولا تحالفا مجتمعيا يمكنه من التعامل مع الأزمات المعقدة.
هذا القصور في تقدير الأولويات يعكس أزمة رؤية أعمق، وهي أن السلطة لا تملك تصورا واضحا لماهية التنمية أو العدالة البيئية، ولا تفهم الترابط بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
ثانيا: أزمة التدبير
الفشل ليس فقط نظريا أو شعوريا، بل تجلى بوضوح في القدرة التنفيذية والنظرية على حد سواء: كيف تدار المشاريع الكبرى؟ كيف يخطط للنهوض الاقتصادي والاجتماعي؟ كيف يقدم النمو والعدالة؟ السلطة اليوم مركّزة، القرار محصور، التداول قليل، الشفافية شبه معدومة، ومشاركة المجتمع المدني شبه مقطوعة.
عندما تفشل الدولة في تأمين الحماية البيئية، أو في مراقبة التلوث، أو في معالجة البطالة أو الهجرة أو الفقر أو الأزمة الجيوستراتيجية (كمشكلة الغاز أو الطاقة)، فإنها تعكس عمق العجز في “التدبير الإستراتيجي” وليس فقط مجرد أخطاء عابرة.
ثالثا: أزمة التسيير
منذ انقلاب 21 يوليو/تموز 2021، تحول النظام السياسي إلى نموذج مفرط في المركزية. القرارات الكبرى تتخذ في القصر دون تشاور أو رقابة، ما جعل الإدارة التونسية تعمل بلا مشاركة ولا مبادرة.
يزيد من تعقيد هذا المشهد، الارتباك المتكرر لقيس سعيد في تعيين المسؤولين على مختلف المستويات، حيث تُجرى التعيينات على أساس الولاء لا الكفاءة، لتتبع لاحقا بحملات عزل تحت تهم الفساد أو التقصير في أداء الواجب.
هذا النهج القائم على الشك والارتجال ساهم في شل الإدارة العمومية، وأفقدها الحد الأدنى من الاستقرار والثقة والقدرة على الإنجاز.
وإلى جانب ذلك، تبدو المؤسسات المنتخبة زمن قيس سعيد، من مجلس النواب إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، مفرغة من أي مسؤولية فعلية، ومنزوعة الصلاحيات، لتتحول إلى واجهات شكلية تكرس حكم الفرد بدل أن تعبر عن الإرادة الشعبية، أو تمارس رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية.
قضية قابس مثال حي، حيث الجهات تنتظر توجيهات المركز، والمجتمع المدني يُقصى من المشاركة، والقرارات تعلن في خطابات مرتجلة بدل دراسات ميدانية. هذه المركزية المفرطة تشل قدرة الدولة على الفعل المحلي، وتحول التنمية إلى شعارات.
رابعا: أزمة الخطاب
ضمن ملامح هذا النظام، ثمة بزوغ لخطاب مغرق في الشعبوية: وعد بـ”إعادة الشعب” أو “السلطة للشعب” أو “انحياز للضعيف”. لكن هذه الشعارات لا تترجم في برامج واقعية قابلة للتنفيذ، ولا تُدعم بنهج يعتمد عليه.
تؤدي الشعبوية بهذا الشكل إلى نتيجتين مدمرتين: الأولى، هي تحييد المنطق الفني والعلمي في السياسات؛ والثانية، هي تفكيك التفاهم الاجتماعي على أساس مشترك. الحسابات الكبرى تغيب لصالح الحسابات السياسية قصيرة الأمد. والمواطن، بدلا من أن يرى سلطته تعمل معه، يشعر أنها تعمل عليه أو تغيّبه.
خامسا: أزمة الصورة
تبدلت صورة النظام، بعد سنوات قليلة من الحكم الفردي المطلق، من صورة “الرئيس المقاوم للفساد” إلى “علامة تجارية” عاجزة عن التعبئة الحقيقية، تعتمد أكثر على الترويج الإعلامي منه على الإنجاز الملموس.
إن غياب إعلام مهني مستقل، وقمع المجتمع المدني، واجتثاث هيئات الرقابة والمساءلة، كلها عوامل عمقت أزمة الثقة بين الدولة ومواطنيها.
وفي مقابل هذا الفراغ، يبرز متحدثون ومدافعون عن الرئيس ومساره المسمى “تصحيحيا”، أغلبهم يفتقرون إلى الكفاءة والمصداقية، ويعرفون بتقلب المواقف وارتزاق الخطاب. كثير منهم تنقلوا بين موائد السلطات السابقة قبل أن يجلسوا إلى مائدة قيس سعيد، بمستوى تعليمي محدود وخبرة تكاد تكون معدومة، وبعضهم تحيط به شبهات الاحتيال والفساد المالي.
هكذا، تحول الخطاب الرسمي إلى صدى لأصوات بلا رصيد معرفي أو أخلاقي، ما زاد من عزلة النظام وفقدانه المصداقية أمام الرأي العام.
النتيجة واضحة، فجوة متسعة بين النظام والشعب، ومسافة شاسعة بين المطالب اليومية والخطابات الرئاسية، ما ولّد أزمة مشروعية لا تقتصر على صناديق الاقتراع، بل تمتد إلى فقدان المعنى الذي يجعل الناس يؤمنون بأن النظام يعمل من أجلهم، لا ضدهم.
ازدواجية الموقف الرئاسي
الغريب في الملف البيئي في قابس هو تناقض المواقف بين ما كان يقوله قيس سعيد كناشط سياسي ومدني، وما يفعله اليوم كرئيس للجمهورية بصلاحيات مطلقة.
خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، ساهم سعيد في رفع منسوب الوعي المدني بمشاكل البيئة، ورفع سقف المطالب لحل الإشكال البيئي والصحي، داعيا إلى معالجة الملوثات، وحماية المواطنين، والمساءلة الحقيقية للمسؤولين عن الانتهاكات البيئية.
لكن بعد أن أصبح رئيسا بصلاحيات واسعة، تغير الموقف: لم يعد هناك تعبئة حقيقية للسلطات أو للشعب نحو هذه القضايا، وغالبا ما استبدل الخطاب الفعال بالشعبوية والتبريرات الإعلامية، ما أفرغ الوعد البيئي من محتواه العملي.
الملف ذاته، الذي كان يوما من أولويات نشاطه المدني، أصبح اليوم رمزا لغياب الإرادة والإجراءات الفعلية، مع اعتماد على الإنكار والارتجال بدل التخطيط والإستراتيجية.
لغة الشعر في مواجهة المأساة
في أزمة قابس، كما في غيرها، جمع قيس سعيد كل ما يرمز إلى فشل السلطة وانغلاقها من نقض للوعود ونكوص عن العهود، وتعامل مع المعارضين المدنيين بالأسلوب ذاته الذي واجه به خصومه السياسيين، في مشهد يعكس تضييقا ممنهجا على كل صوت مخالف.
بدا الرئيس، مرة أخرى، غائبا عن جوهر الأزمة؛ فبدلا من أن يقدم في كلمته أمام رئيسة حكومته حلولا ملموسة أو خطة إنقاذ لأهالي قابس، اختار أن يبتعد عن الموضوع تماما، متجها إلى استطرادات لغوية واستشهادات شعرية.
قال سعيد كما قال جرير:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع
وأضاف أيضا
لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغا البعيث جدعْت أنف الأخطل
هكذا تحدث الرئيس يوما بعد مسيرة شعبية حاشدة في قابس (130 ألف مشارك حسب بعض التقديرات)، في وقت كان ينتظر فيه الناس خطابا يعكس جدية الدولة لا ارتجال الحاكم. مشهد لم يثر استهجان خصومه فحسب، بل أحرج حتى أنصاره، مؤكدا أن السلطة فقدت بوصلتها، وأن رأسها يعيش في عزلة تامة عن الواقع السياسي والاجتماعي والبيئي للبلاد.
تونس: بلد بلا أفق
عندما يجتمع كل ما سبق: رؤية ضبابية، أداء محدود، خطاب متدهور، مجتمع مدني ضعيف، إعلام محاصر، تكون النتيجة الطبيعية، بلدا بلا أفق.
التونسي اليوم لا يرى كيف يغير واقعه، ولا كيف يشارك في القرار. الاحتقان يتراكم، والمطبات تلوح مع غياب الشفافية، ازدياد البطالة، هجرة الشباب، ضعف الخدمات، وأزمة الثقة، كلها عوامل تضاف إلى فاتورة الحكم.
قابس اليوم ليست مجرد مدينة ملوثة أو أزمة بيئية جهوية، إنها اختبار وطني حقيقي لمصداقية الدولة التونسية ولقدرتها على حماية مواطنيها وإدارة أزماتها. كما أنها مرآة لانهيار الثقة بين الشعب والسلطة، ونتيجة مباشرة لانفراد الحكم بالقرار وغياب الشفافية والمساءلة.
أزمة قابس ليست حادثة معزولة، بل مرآة للسياسات العامة التي أهملت التنمية المستدامة، وغيّبت العدالة الاجتماعية، وأهم من ذلك، نسفت الثقة بين المواطن والدولة.
ليس الحل في الخطابات الشعرية أو الشعبوية، بل في الإستراتيجيات الواقعية، في بناء مؤسسات فاعلة، في تمكين المجتمع المدني، وفي مواجهة المشكلات الكبرى بجرأة وعلم ومعرفة. تونس بحاجة إلى دولة تحمي حقوقها، قبل أن تحمي صورتها أو تروج لشعاراتها.
الأمل لا يزال ممكنا، لكن الزمن ينفد، والحرص على مستقبل قابس وبقية الجهات التونسية يتطلب إرادة حقيقية وتغييرا ملموسا قبل أن تصبح الكارثة عصية على المعالجة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستستعيد الدولة توازنها، أم إن التدهور سيستمر في غياب رؤية واضحة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف