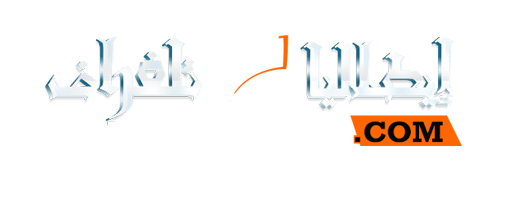عبد القادر الفرساوي
في سيدي الطيبي التابعة لمدينة القنيطرة، تلك البقعة المنسية التي تحوّلت إلى توأم ل : “طورا بورا”، حيث القانون مجرد وهم، والرصيف ساحة معركة مفتوحة لكل أنواع الجرائم، استيقظت البلدة على فاجعة جديدة. لكن هل كانت صدمة؟ لا. هنا، لا يمر يوم دون خبر دموي، دون قصة مأساوية، دون حادثة تخترق الروح وكأنها طعنة في ظهر الأمل. سيدي الطيبي ليست قرية، إنها حقل ألغام، كل من يسير فيه يعرف أنه قد يكون التالي في قائمة الضحايا.
في تلك الليلة، كان الهواء مشبعا بروائح رمضان، وكانت المساجد تضج بصلاة التراويح، لكن في أحد الأزقة، كانت يد الظلام تمتد، تبحث عن فريسة جديدة، عن ضحية تُضاف إلى القائمة الطويلة لحكايات الرعب التي صارت جزءا من يوميات سيد الطيبي. جيداء، ابنة الخمس سنوات، خرجت تلعب كما تفعل كل ليلة، لكن الفرق هذه المرة أنها لن تعود.
في منطقة حيث المخدرات تباع كأنها السلع الأساسية، و تستهلك على قارعة الطريق و في المقاهي كأنها كعك العيد، حيث اعتراض طريق المارة بأسلحة بيضاء و كلاب شرسة لبث الرعب وكأننا في أفلام العصابات، حيث الدم يسيل بلا حساب، وحيث الأخبار اليومية تحمل مزيجا من الفوضى والرعب: فلان قُتل، طفل اغتُصب، سيارة احترقت، شاب خُطف هاتفه، رجل في العناية المركزة بسبب جرعة مخدر قاتلة، آخر تسمم بطعام فاسد، عائلة بأكملها ضُربت وسُلبت، ومشاجرة انتهت بإصابات خطيرة… كيف يمكن لطفلة بريئة أن تنجو في وسط هذا الخراب؟
لم يكن أحد يتخيل أن المصيبة الجديدة ستحمل وجها صغيرا بريئا، أن تكون الضحية هذه المرة ليست شابا ضائعا في دوامة المخدرات، ولا تاجرا تصفية حساب، ولا فتاة سُلبت في الشارع، بل طفلة لم تتجاوز السنوات الخمس، سُحبت من عالم البراءة إلى جحيم لا يوصف.
حين خرجت أمها من المسجد، بحثت عنها، نادت عليها، سألت الجيران، لكن لا أحد رأى شيئا. اختفت جيداء، وكأن الأرض ابتلعتها. مواقع التواصل امتلأت بصورها، الناس كانوا يأملون أنها ربما تائهة في زقاق ما، ربما نائمة في ركن منزوٍ. لكن الحقيقة كانت أقسى من أي احتمال.
في ذلك الصباح البارد، لم تكن هناك أشعة ذهبية تتسلل بين الأبنية و لم تكن الشمس قد أشرقت على حاوية القمامة، بل كانت الغيوم الكثيفة تنوح، والمطر ينهمر كأن السماء تبكي و تشارك في الحداد لحزنها على فقدانها، كانت قطرات المطر تغسل شوارع سيدي الطيبي دون أن تستطيع غسل العار الذي خلفه وحش بشري على جسد صغير هش.
كانت المياه تتجمع في الأزقة الموحلة، والأرض تعكس بؤس المشهد، لكن شيئا أقسى من الطين كان ملقى هناك، جسد جيداء، ممددا داخل الحاوية، كما لو أن الحياة لفظتها كما يفعل هذا العالم مع الضعفاء. لم تكن تبحث عن دفء أمها، لم تكن يداها تمتدان نحو الحياة، فقد أخذها عمّها الوحش إلى عالم آخر، حيث لا خوف ولا ألم، حيث المطر لا يبلل سوى ذكرى طفلة كان يمكن أن تكون شيئا جميلا في هذا العالم القاسي.
كان الجاني لا يزال قريبا، لم يهرب بعيدا، لم يبحث حتى عن ثغرة للاختباء، لأن الوحوش لا تعرف الشعور بالذنب، بل فقط تنظر إلى ضحاياها كما ينظر الصياد إلى فريسته بعد أن يشبع. شاب في السادسة عشرة، عمّها، دمها، لكنه لم يرَ فيها سوى جسد صغير يمكن سحقه تحت غرائزه المسعورة.
قبضت عليه الشرطة بعد ساعات، اعترف، سرد جريمته وكأنها فعل عادي، لم يتلعثم، لم يبدُ عليه الندم، فقط قال إنه اغتصبها، خنقها، ثم ألقى بجسدها كما تُلقى قطعة قماش قديمة. لم يفكر للحظة أنها ابنته من جهة الدم، لم يسأل نفسه إن كانت ستصرخ باسمه ذات يوم، إن كانت ستكبر وتناديه بحب، لم يرَ في عينيها سوى فرصة لإشباع رغباته المظلمة.
المغرب كله اهتز، لكن سيدي الطيبي لم تهتز، فقد اعتادت على الجرائم. في هذا المكان، الموت ليس مفاجأة، بل هو جزء من الحياة اليومية، مألوف مثل أصوات الدراجات النارية التي تحمل تجار المخدرات، مثل العراك الذي يندلع كل ليلة في الحانات السرية، مثل الأخبار التي تبدأ بـ”فلان قتل فلان” أو “تم اعتراض سيارة فلان” أو “فلانة اختُطفت وسُلبت”.
المواطنون هناك لا ينتظرون العدل، لأنهم يعرفون أنه مجرد كلمة في قاموس لم يعد يُستخدم. لكن أمام هذه الجريمة، تعالت الأصوات المطالبة بأشد العقوبات، بالإعدام، بالقصاص، بأي شيء يعيد بعضا من العدالة المسروقة. لم تكن هذه الجريمة الأولى، فقبل خمس سنوات، كانت مدينة طنجة قد اهتزت على وقع قضية “عدنان”، الطفل الذي تعرض لنفس المصير ، وكأن الشوارع لم تعد آمنة، وكأن وحوشا تختبئ في كل زاوية، تترقب لحظة الغفلة، لتنقضّ على البراءة وتمزّقها دون رحمة.
لكن هل ستكون هذه الجريمة نقطة تحول، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة المآسي؟ هل ستظل مثل هذه الجرائم تتكرر طالما أن العقوبات، رغم شدتها، لم تمنع الذئاب البشرية من تكرار وحشيتهم؟ وهل يكفي القانون وحده، أم أن الردع الحقيقي يبدأ من تفكيك هذه البؤر الإجرامية قبل أن تتحول إلى مستنقع دائم للعنف؟
جيداء ليست مجرد طفلة قتلت، إنها رمز لكل براءة تم انتهاكها، لكل صرخة لم تصل، لكل خوف استوطن قلوب الأمهات اللواتي بتن يخشين أن يتركن أطفالهن لحظة واحدة. هي ذكرى لن تُنسى، ولو حاول العالم أن يدفنها تحت ركام التحقيقات والإجراءات الباردة.
في مكان ما، ربما، روحها الصغيرة تراقب، تتساءل: لماذا؟ لماذا كانت نهايتها بهذا الشكل؟ لماذا لم يكن هناك من يمنع عنها هذا المصير؟ لماذا خُذلت وهي في الخامسة من عمرها؟
لكن لا إجابة. فقط صمت طويل، وليل آخر ينتظر طفلة أخرى، في سيدي الطيبي، حيث الحياة والموت وجهان لعملة واحدة، حيث القانون بلا سلطة، والوحوش تتجول بحرية، منتظرة ضحية جديدة.