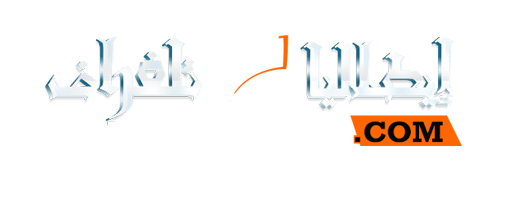عبدالله هداري
كاتب وباحث مغربي
من المفيد أن نتساءل اليوم عن الأشياء التي قد تربط “جيل زد” في المغرب بنظرائهم في بقية بقاع العالم التي خرج فيها الشباب ذوو المزاج الرقمي، معبّرين عن سخطهم وغضبهم الشديدَين. وبعيداً من التكنولوجيات الحديثة التي أسهب في شرحها كثيرون، ثمّة جواب جزئي، لكنّه كافٍ ليساعدنا (إلى حدّ بعيد) في جعل الصورة أكثر وضوحاً. يقول الكاتب المقيم في نيبال أميش راج مولمي، في مقالته “من الشارع إلى ديسكورد… كيف أطاح جيل زد النيبالي الحكومة” (نشرت في 24/9/2025 في موقع مؤسّسة كارنيغي للسلام الدولي)، في سياق وصفه تفاعل الحكومة النيبالية مع الاحتجاجات، إن هذه القيادة المُسنّة افترضت أن السخط الظاهر في الشارع ما هو إلا جزء من اليوميات العادية للحياة السياسية، فلا خوف منها، وهي ممّا يمكن تجاهله إلى حين خفوته. وليس من باب المصادفات، ما دمنا نتحدّث عن مشتركات جيلية وسياسية، أن العبارة نفسها سيصرّح بها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في سياق حديثه عن الاحتجاجات في المغرب، معتبراً ذلك مسألةً صحيّةً للسياسة المغربية. وأردف عباراته هذه بكلمات لها نصيب كبير في الرفع من منسوب غضب الشباب، حينما قال متهكماً إن “الاحتجاجات ستستمرّ وأنا أيضاً سأستمر في منصبي”.
وإذا أردنا أن نقيس علاقة الوقاحة الحكومية هنا بمنسوب تأجيج الغضب عند الشباب، وعند المغاربة عامة، فلنا أن نعود إلى واقعة أخرى (وللأسف!) مع الوزير نفسه، حينما عبّر في إثر أزمة نزاهة مباراة المحاماة التي أجّجت احتجاجاتٍ كثيرة، فعلّق بغرور كبير على مسألة دراسة ابنه في كندا، إن والده من الأغنياء! ولعلّ هذه الواقعة التي حملها مقطع فيديو قصير، كشفت النهج السياسي لهذه الحكومة الذي يجعل من الوقاحة السياسية أسلوباً في الردّ والمراوغة واستعراض القوة والسيطرة، من دون اكتراث لمشاعر الشباب والمواطنين، فما بالك بالاكتراث بحقوقهم.
لم يبدأ تضخّم كرة الغضب هذه من هاتَين المسألتَين، بل هنالك حوادث كثيرة، مثل حصول شركة تابعة لرئيس الحكومة على نصيب من صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء. وعندما ووجه هو الآخر بسيلٍ من الانتقادات التي تكاثرت كالذباب من حوله، علّق في جواب تحت قبّة البرلمان، وأمام أنظار جميع المغاربة، بأنه إذا استمرّت هذه الانتقادات سينسحب ومعه جلّ المستثمرين الذين أطلق عليهم صفة أصدقائه. وهو جوابٌ لم يجد فيه المغاربة غير التهديد نفسه، المصحوب هو الآخر بالوقاحة والاستهانة بمؤسّسات البلاد التي كان من المتوقّع لها أن تلعب دوراً في صدّه، أو إيقافه عند حدّ ما.
يواجه “جيل زد” المغربي حكومة فقدت حسّ الإصغاء، وسياسة بلغت حدود الوقاحة
ولنا أن نضيف رفع الدعم عن المحروقات، وما خلّفه من فساد كبير على مستوى الأسعار واستغلال قسري متعمّد لجيوب المغاربة وضرب قدرتهم الشرائية، وكذلك الأزمة غير المسبوقة في قطاع التعليم، التي توقفتْ جرَّاءها الدراسة ثلاثة أشهر، في سابقة لم يكن لها مثيل في تاريخ المغرب… وجميعها جعلت المغاربة، أبناءً وأسراً، يستشعرون قلقاً وغموضاً غير مسبوقين تجاه المستقبل، وكانت محطّة احتقان وغضب داخلي حقيقي، يصعب القول إنهم قد تجاوزوها فعلياً. والأمثلة من فرط كثرتها صار جردها من باب العبث ومضيعة الوقت. لذا، ليس سرّاً أن الغضب والاستياء اللذين نراهما متأجّجين في الشارع اليوم إنما هما قمّة جبل الجليد التي تخفي تراكمات نفسية ومادية مركّبة، بلغت نهاياتها القصوى متولّدةً من أجيال من الفساد والاستغلال وموت السياسة.
يصف عالم السوسيولجيا الألماني أندرياس ريكفيتز نفسية الخسارة هذه في مقالته “الغرب المفقود” (نشرت في 5/10/2025 في “نيويورك تايمز”) بأن المجتمعات حينما تفقد إيمانها بأن المستقبل يمكنه أن يكون أفضل، تصبح الخسارات أكثر وطأة وتأثيراً. وإذا كان كل جيل من الشباب النيبالي قد أطاح حكومةً، بحسب تحليل أميش راج مولمي، من دون القدرة على الحفاظ على تغيير دائم، فيعودون دائماً إلى نقطة الصفر، فإن أندرياس يربط ذلك، إلى جانب فساد الحكومات وفشل سياساتها، بالخسارات العالمية، ويقصد بها المناخية والاقتصادية والجيوسياسية. ولهذا لم تعد هنالك ضماناتٌ أن ما يحدث في عالمنا اليوم مجرّد حلقات عابرة. بمعنى أن تجربة الخسارة، بحسب عبارته، تسير في اتجاه التناقض الصارخ والكلّي مع عقيدة التقدّم الحداثية.
لا يمكن إصلاح السياسة تحت سقف النظام العالمي إلا عبر القنوات الديمقراطية
وإذا أردنا أن نربط المسألة بالشباب المغربي، فذلك ممّا يتشاركون فيه مع شباب نيبال وشباب العالم كلّهم، فإن جميعنا يتذكّر لحظة خروج الشباب عام 2011 (20 فبراير/ شباط)، التي كانت بمثابة إسقاط مرحلة سياسية سابقة تجرّ أذيالها منذ لحظة الملك الراحل الحسن الثاني، مؤذنةً بمرحلة سياسية جديدة توّجها الدستور الجديد الذي أعلنه الملك محمّد السادس آنذاك. غير أن التغيير سيتوقّف عند نقطة الدستور، مع الاحتفاظ بحقّ تنزيله إلى أجل غير مسمّى. ومع خروجات “جيل زد” اليوم في المغرب، تسقط مرحلةٌ سياسيةٌ (حكومة) أخرى من أعين الناس، رغم أنها لا تزال تهوي في قاع سحيق من الفساد والوقاحة والاستغلال، وهنا تواجهنا الأسئلة المقلقة التالية: هل من سياسات مستقبلية يمكنها أن تجنّبنا حالة العود هاته؟ وحسب عبارة أندرياس: هل يمكن أن نتعلّم من الخسارة؟ وكيف يمكن أن نتعامل معها بعد هذه الأشواط كلّها من الفشل؟
وفيما يشبه الإجابة عن هذه الأسئلة، يعتقد الكاتب أميش راج مولمي أن الشباب النيبالي مدعوّ اليوم إلى أن يحسن التصرّف هذه المرّة، فلا ينبغي انحسار حراكاتهم عند الواجهة الرقمية، وداخل أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، فالسياسة كما نعلم لا يحدث أيُّ إصلاح فيها تحت سقف النظام العالمي الذي نعيش فيه اليوم إلا عبر القنوات السياسية المؤسّساتية والديمقراطية. وهنا تواجهنا فيما يخصّ الحالة المغربية مسألةٌ في غاية الخطورة، وهي نقطة مفصلية في استفحال أوضاع اليوم، ونقصد تحديداً التدخّل في سير “الحياة الطبيعية للأحزاب السياسية”، أو ما سمّاه الوزير والأكاديمي عبد الله ساعف بسياسة “الحدّ الأدنى للسياسة”.
لاحظ الجميع حجم السخط الذي كان موجّهاً إلى الأحزاب السياسية في المغرب جميعها، بمختلف ألوانها الأيديولوجية. وهو الأمر نفسه الذي عبّر عنه جلّ محتجّي “جيل زد” في العالم، تعبيراً عن أزمة سياسية حقيقية تواجهها هذه البلدان، التي لا تريد أن تتجاوز عنق الزجاجة، لتظلّ في منطقة رمادية لا هي بالديمقراطية ولا هي بالمستبدّة الفجّة، وهذا ما عناه ساعف بمنهجية الحدّ الأدنى التي يكرّسها النظام ليبقيها حيّةً، لكنّها مؤسّساتٌ فاقدةٌ القدرة على التغيير والتأثير في واقعها.
لاحظ الجميع حجم السخط الذي كان موجّهاً إلى الأحزاب السياسية في المغرب جميعها، بمختلف ألوانها الأيديولوجية. وهو الأمر نفسه الذي عبّر عنه جلّ محتجّي “جيل زد” في العالم
وإذا كانت أفعال العقلاء منزّهةً عن العبث، حسب القاعدة الفقهية الشهيرة، فإن الحلول الممكنة لتساؤلات أميش راج مولمي، نحو: كيف لنا أن نحافظ على التغيير؟ وكيف لأبناء هذا الجيل أن يُحسنوا التصرّف؟ قد نعثر على بعضها عند أندرياس الألماني، وهو يحاول أن يصف طبيعة مشاعر جيل اليوم الذين يغلب عليهم الغضب، والإحساس بظلم عالمي ناجم من عيش واقع الخسارة. يقول إن علينا أولاً ترسيخ سياسات المرونة، بتعزيز النظم الصحّية، والأمن العالمي (وهذان أمران يتجسّدان في الحالة المغربية في مسألة المطالبة بالإصلاح الصحّي ووقف التطبيع مع إسرائيل). ويضيف مسألة استقرار الإسكان، وحماية مؤسّسات الديمقراطية الليبرالية. ثمّ يمكن المرور بعدها لتقييم الخسائر مكاسباً محتملةً. بمعنى: كيف نجعل من خسارتنا النسبية بعد تجربة الدستور في 2011 مكسباً للمستقبل، حتى نجاوز نقطة الحدّ الأدنى للسياسة، وتكرار الأزمة بصور جديدة. وثالثاً الابتعاد ما أمكن عن السياسات الشعبوية التي تعد بأشياء لم يعد من الممكن تحقّقها بذلك الزخم المنتمي لعالم الستينيّات والسبعينيّات. وآخر هذه الحلول يسمّيها “الاعتراف” و”التكامل”. وتعني عند تطويعها بحسب الحالة المغربية أن ندمج المخيّلة الديمقراطية، بحسب عبارة الكتاب، مع واقع الخسارة. تفكير كهذا يمكنه أن يضعنا حسب أندرياس في مستوى من النضج يجعلنا نفكّر في إصلاح التعليم بعيداً من الأوهام الشعبوية التي لا تخدم غير الشغف الانتخابي الموهوم، فنُعيد بذلك تعريف التقدّم المرتبط بالتعليم وفق حالتنا الفعلية.
إننا أمام جيل لا يشترك فقط في مشاهدة “مونكي دي لوفي”، القرصان المرح، وبطل الأنمي الشهير “وان بيس”، بحسب ما جاء في افتتاحية صحيفة الغارديان البريطانية (في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، وإنما الرابط الأبرز هو الاستياء العارم الذي خلّفه خذلان كبار السنّ من السياسيين، والتحوّلات الجيوسياسية، وتقلّبات المناخ العالمي، مضافاً إليها اتساع الفوارق ونهاية عصر الطبقة المتوسّطة المتجانسة، وتولّي عهد الحداثة الصناعية ونظام الهيمنة الغربية أحادية القطب، حسب أندرياس. ولهذا، ليس أمامنا إلا أن نفكّر في الحلول، مستحضرين هذه المتغيّرات العالمية كلّها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف