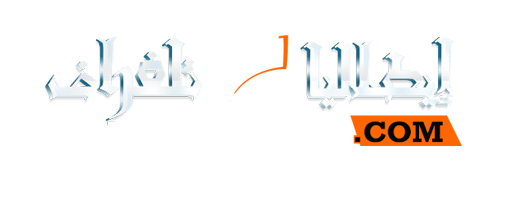*معتز الخطيب
في ظل التأملات التي أعقبت انتشار وباء كورونا، تحدث كتّاب عما أسموه “إفلاسا أخلاقيا”، أو “أزمة أخلاق”، أو “انهيارا أخلاقيا”. وثمة تأملات ذات طابع يساري مالت إلى مثل هذا وإلى الحديث عن أزمة الرأسمالية والتبشير بنهايتها؛ فقد دعا الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك مثلًا إلى إحياء شيوعية من نوع جديد، وأدرج المؤرخ الأميركي مايك ديفيس كورونا ضمن ما أسماه “الأوبئة الرأسمالية”. فإلى أي مدى يصدق هذا اليوم؟ وما المظاهر التي تدفع إلى مثل هذا القول؟
يمكن رصد مظاهر عدة للتدليل على ما سبق، ألخصها في الآتي:
1. حديث بعضهم عن تهاوي مقولات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في ظل انتشار وباء كورونا.
2. إثارة النقاش حول التضحية بكبار السن نتيجة تزاحم المرضى وعدم القدرة على تلبية كل الاحتياجات في آن واحد، وهي مسألة كانت موضع نقاش في بعض الولايات الأميركية وفي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
3. بروز أولوية الاقتصاد على حياة الإنسان؛ فالبعد الاقتصادي شغل سببًا مهمًّا في سياسات الوباء دوليا وعربيا؛ وكثير من الدول تأخرت في اتخاذ سياسات وقائية؛ بسبب التكلفة الاقتصادية العالية لذلك، مما أدى إلى انتشار الوباء واضطرت في ما بعد إلى اتخاذ الإجراءات التي تباطأت فيها من قبل.
4. تلاشي مفهوم “التضامن الآلي” الذي عُدّ سمة المجتمع الحديث و”الأسرة الدولية”، في مقابل سيطرة النزعة الفردية والانفصال عن الجماعة ومفاهيم العزلة المنزلية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، وكلها سياسات فرضها انتشار الوباء. ومن اللافت أن مثل هذا الحجاج قد طُرح في الأزمنة الكلاسيكية في ظل الطاعون؛ فقد رأى بعض الفقهاء في غرناطة في القرن الثامن الهجري أن القول بالعدوى سيؤدي إلى العزلة والذعر الاجتماعي، ويدفع الأفراد إلى الانشغال بأنفسهم فقط والتخلي عن واجباتهم الاجتماعية والأسرية، مما يقود إلى تفكك النسيج الاجتماعي وغياب التضامن وكلها واجبات دينية وأخلاقية.
5. “العزل المنزلي” أدّى إلى سياسات غير عادلة، كتسريح موظفين، وإجبارهم على التنازل عن أجورهم، أو الخصم منها، وحرمان الفئات الضعيفة من مصدر رزقها اليومي إلى غير ذلك.
6. التضييق على الحريات الأساسية والخوف من تحول ما هو طارئ في ظل الوباء إلى معياري، وما هو مؤقت إلى دائم، ومن ثم يخسر الإنسان الحديث جزءًا من حرياته وإنسانيته نتيجة هذه السياسات فيما لو باتت طبيعية أو عادية.
السؤال الأخلاقي لم يولد مع الوباء، وإن كانت الأوبئة تعيدنا إلى أسئلة أخلاقية تتصل بفكرة التقدم التقني والسيطرة على الطبيعة، وإلى أسئلة تتصل بتقويم أفعال الإنسان ومصيره في الدنيا، فسواء كان الفيروس طفرة أم تصنيعًا فهو يثير مشكلات أخلاقية ترجع إلى أن التقنية نقلتنا من موقف المراقب للطبيعة إلى موقف المتدخل فيها، ومن ثم حدث تصعيد من النظر البسيط إلى النظر المركب.
ورغم كل ذلك، فإن الحديث عن (إفلاس، أو أزمة، أو انهيار) يُعدّ مبالغة، ولو شئنا استخدام لغة علمية لتوصيف ما حدث، يمكن أن نقول إن الوباء أفرز مجموعة من الأسئلة والإشكالات الأخلاقية التي تحتاج إلى معالجة ضمن حقل الأخلاق الذي ينشغل بهذا النوع من الأسئلة تحديدًا. وقد باتت الأخلاق اليوم حقلًا تخصصيًّا تطبيقيًّا ينشط للإجابة عن الأسئلة التي تفرزها التطورات العلمية والتقنية، فضلًا عن أن سؤال الأخلاق لا يفارق أفعال الإنسان وفضائله، فهو إنما يبحث في تقويم أفعال الإنسان (ونسميه الأخلاق المعيارية) وصفات الفاعل (ونسميه أخلاق الفضيلة).
ويثير الوباء أسئلة ومناقشات أوسع من فكرة القانون؛ من ذلك مثلًا سؤال الفرق بين ما هو طبيعي وما هو طارئ كما سنوضح لاحقًا. كما يثير أسئلة ذات طبيعة عملية ومعيارية، وهي أوسع من أن يستوعبها القانون؛ لأنها تفترض أفعالا مركبة وتفصيلية، وأبعادًا إنسانية تستعصي على الضبط القانوني، وتستلزم توجيهات واستنفار معانٍ داخلية دينية وميتافيزيقية، كما هو شأن كل الأوبئة والكوارث الطبيعية. كما أن حقل الأخلاق يحيلنا إلى أخلاق الفضيلة التي لا تقع أصلا ضمن مجال اهتمام القانون.
فالوباء ليس حدثًا جديدًا في تاريخ البشرية، بل هو حدث مكرر، لكنه حدث غير مألوف في التاريخ المعاصر لأنه ساد ظنٌّ بأننا قد تجاوزنا الأوبئة مع التوغل في الأزمنة الحديثة؛ حتى تُوُهِّم أن الأوبئة من ظواهر المجتمعات التقليدية، وأنه كلما توغلنا في التقدم العلمي والتقني انحسرت الأوبئة!
والسؤال الأخلاقي لم يولد مع الوباء، وإن كانت الأوبئة تعيدنا إلى أسئلة أخلاقية تتصل بفكرة التقدم التقني والسيطرة على الطبيعة، وإلى أسئلة تتصل بتقويم أفعال الإنسان ومصيره في الدنيا، فسواء كان الفيروس طفرة أم تصنيعًا فهو يثير مشكلات أخلاقية ترجع إلى أن التقنية نقلتنا من موقف المراقب للطبيعة إلى موقف المتدخل فيها، ومن ثم حدث تصعيد من النظر البسيط إلى النظر المركب.
وكما أوضحت في دراسة لي عن “التدخل الجيني” بين النظرين الفقهي والفلسفي، يمكن أن نميز هنا -بالعودة إلى أرسطو ويورغان هابرماس- بين 3 مواقف؛ الأول: الموقف النظري الذي يراقب الطبيعة بطريقة غير مصلحية. والثاني: الموقف التقني الذي يعمل بهدفٍ قَصدُه الإنتاج فيتدخل في الطبيعة عبر وضع الوسائل واستعمال الأدوات. والثالث: الموقف العملي الذي يعمل تبعًا لقواعد الحرص على الأعراف. ولكن العلوم التجريبية أسهمت في المزج بين الموقف النظري “لمراقب متجرد” يسعى إلى فهم ما يجري، والموقف التقني “لمراقب متدخل” باحث عن تأثيرات تجريبية. ومن ثم علينا أن نواجه أسئلة وإشكالات أخلاقية تقتضي الانتقال من الوصفي إلى المعياري، وهنا تشغل الأخلاق حيزًا مركزيًّا؛ لأنها تتناول ما هو معياريّ. وإذا كانت التقنية والتقدم العلمي عامة قد زاد من الإمكانات المتاحة للإنسان ووسّع حدود قدراته، فإن الأخلاق تدفعنا إلى تقويم ما إذا كان كل ممكن يجوز فعله.
والتمييز بين الوصفي (كل ما هو ممكن) والمعياري (ما يجوز فعله مما هو ممكن) يفرض علينا التمييز بين سؤالين؛ الأول: السؤال الطبي الذي يمثل المراقب المتجرد والمتدخل، حيث لا مسافة تفصل بين الممكن والموجود. والثاني: السؤال الأخلاقي حيث ليس كل ممكن يجوز تحويله إلى موجود.
فالأسئلة الطبية تتّسم بأنها ذات طبيعة تفسيرية، وتؤسَّس على معلومات (informative)، وهي أسئلة عملية، وكاشفة (تكشف عن مجهول)، من قبيل: كيف نوقف انتشار الفيروس؟ وما العلاج اللازم للحفاظ على حياة أكبر عدد من الناس؟ أما الأسئلة الأخلاقية فهي معيارية، ونظرية وعملية في الآن نفسه؛ وذلك أن الأخلاق حقل متعدد التخصصات، ولا يقوم العملي من دون وجود أساس نظري، من قبيل: من الأحق بالعلاج؟ وهل يمكن تسويغ الحظر أخلاقيًّا؟ وكيف يمكن تسويغ منع التجمعات (كالأسواق والمساجد) درءًا لانتشار الوباء؟ وفي حالة تعارض القيم والحقوق أيها نقدّم؟ وكيف نوازن بينها؟
ورغم تنوع وكثرة الأسئلة والإشكالات الأخلاقية التي أفرزها فيروس كورونا، فإنها ترجع بالأساس إلى مركزية الإنسان، وأن التكنولوجيا تعجز أحيانًا عن توفير الحماية من الألم والموت، بل تغدو الرفاهية مسألة ثانوية أيضًا. ويمكن أن نردّ النقاش هنا حول الإنسانية إلى محورين رئيسين: الحياة نفسها وما إذا كانت قيمة بذاتها، ونوعية الحياة وكفاءتها.
فضمن الفئة التي تنحاز إلى قيمة الحياة بذاتها، نجد الفيلسوف الألماني هابرماس يستفظع أن تقرر جهة ما تقديم العلاج لشخص وترك آخر يموت بسبب الاكتظاظ الذي عرفته المستشفيات؛ وكأن هذا السؤال يبدو له أنه يردّنا إلى حالة بدائية، كما نجد ديريك بارفيت يفضّل في كتابه (Repugnant Conclusion) عالمًا يعيش فيه الملايين من الناس حياة بائسة على عالم تعيش فيه أقلية سعيدة.
وضمن الفئة التي تنحاز إلى فكرة نوعية الحياة لا إلى الحياة نفسها، نجد الفرنسي أندري كومت سبونفيل يحذّر من جعل الصحة هي القيمة العليا لوجودنا، ويتساءل: ما قيمة الحياة من دون صحة الأبدان؟ يقصد ما أهمية كبار السن؟ فهو قلِقٌ على مستقبل أبنائه أكثر من صحته. كما نجد جورجيو أغامبين يحذّر من عسكرة الفضاء العمومي في زمن الجائحة، ومن تقييد حرية المواطنين وحركتهم. وقد رأى أن الموت أفضل من قضاء حياة غير لائقة محبوسين في المنزل ومعزولين ومن دون إمكانية اللقاء، ومن دون أن نكون قادرين على ممارسة الوظائف الأساسية للمجتمع الحر.
ومما يتصل أيضًا بكفاءة الحياة ما فرضه فيروس كورونا من سياسات وتقييدات يمكن تلخيصها في الآتي:
1. عالم العزل المنزلي ممتلئ بالسكون والحذر والريبة والملل والحرمان والترقب والغياب، أي الاختيار بين ثنائية الحماية أو الحرية.
2. تراجع مفهوم الحياة الباذخة والعودة إلى مستوى (الحاجات الأساسية).
3. تفعيل صورة جديدة للتفاعل والتواصل الجسدي بين البشر، وهو نمط مختلف من العلاقات الاجتماعية والعمل.
4. التباعد هو أساس العيش الآمن، مما فرض تغيرات في العادات والممارسات الدينية التقليدية.
5. اختزال معنى الحياة التي تحولت إلى ما يشبه “الزمن الراكد”؛ لأنه تتلاشى في هذا الزمن الحركة أو تضيق إلى أبعد مدى، والزمن إنما يتسع ويثرى بالحركة.
أي إننا قد تراجعنا في زمن كورونا إلى مستوى الضروري، وتضاءل ما هو حاجي وتكميلي، وهذه القسمة الثلاثية (الضروري والحاجي والتحسيني) هي قسمة قيمية وعملية تتسم بالمرونة، وهي قابلة للتطبيق والموازنة بين أحوالها وتطبيقاتها، ويمكن أن تكون معيارًا للتقويم؛ بخلاف بعض المنظورات الفلسفية التي تغرق أحيانًا في المثالية وتنغمس في ما هو كلي ومجرد وجذري أحيانًا. في حين أنه في الواقع ثمة مستشفيات وأشخاص عليهم أن يواجهوا حالات عملية وعليهم أن يتخذوا قرارًا بشأنها، كالسؤال الذي طرح حول من هو الأحق بالعلاج عند التزاحم، كما أن الفرز بين المرضى بناء على جودة الحياة يفتح الباب لإشكالات أخلاقية لا حدود لها.
الطوارئ لا تعني الخروج على المبادئ الكبرى، أو اختراع مبادئ مستقلة لحالة الطوارئ، وإنما تعني أننا أمام حالة لم تتشكل بعد، تقتضي السرعة في الاستجابة لها، والتقويم المستمر للوضع والعمل على الخروج من حالة الطوارئ نفسها إلى الحالة الطبيعية، فهنا لا نبحث عن تشريع لها؛ بقدر ما نبحث عن استجابة راهنة لها.
يتعامل حقل الأخلاق -كما سبق- مع أسئلة عملية تثيرها الأوبئة، فهي تتصل بمعضلات أخلاقية تتطلب علاجًا عمليًّا، وتفرض علينا القيام بموازانات بين القيم المتعارضة وتقديم التعليلات اللازمة، بعد تحديد المبادئ الحاكمة للأفعال والتصرفات. ونقسم عادة الأخلاق إلى 3 مستويات: الأخلاق المعيارية (وتتناول الأحكام والتقويمات الجوهرية للأفعال والأشخاص)، والأخلاق التطبيقية (وتتناول الحالات العملية والمهنية)، وما بعد الأخلاق (وتتناول الأسئلة الكبرى عن اللغة الأخلاقية ومصادر الأحكام الأخلاقية).
فالأخلاقيات التطبيقية تشمل حقولًا متعددة منها: الأخلاق الطبية وأخلاقيات الصحة العامة. فالأخلاق الطبية تناقش الإشكالات المتصلة بصحة الأفراد (كالإجهاض، والتدخل الجيني، وتقنيات الإنجاب الصناعي …). وأخلاق الصحة العامة تناقش الإشكالات المرتبطة بصحة المجتمع والسياسات الصحية، وهي مسؤولية وواجبات الدولة. ويمكن أن نفرّع على أخلاقيات الصحة العامة أخلاقيات الأوبئة وما يتصل بها، مثل الحجر الصحي (الكرانتينا)، والإعداد لحالة الطوارئ (ethics of emergency preparedness) وغير ذلك.
وفي حقل الأخلاقيات نميز بين حالة الطوارئ والأحوال الطبيعية، فلا داعي لتلك التعميمات التي يقع فيها بعض الفلاسفة أو بعض اليساريين حول وجود أزمة أخلاق أو فشل أخلاقي؛ لأننا في النهاية أمام سؤال عملي أساسًا، والتمييز بين الضروري والحاجي والتحسيني تمييز مهم وملائم لمثل هذه الموازنات، وفي أوقات الطوارئ أيضًا. ولا بد من أن نميز في الحديث عن الطوارئ بين المجال الأخلاقي والمجال السياسي؛ فقد سادت قوانين الطوارئ لدى الأنظمة الشمولية في القرن الماضي، وهذا يختلف عن حالة الطوارئ في المجالين الطبي والأخلاقي. وهنا يتجلى الفرق بين القانون والأخلاق، فالقانون تشريع للأحوال الطبيعية، والطوارئ حالة مؤقتة واستثنائية، أما قانون الطوارئ فهو اختراع شمولي لتوفير غطاء قانوني لعسف الدولة، وإيجاد إطار ناظم للاستبداد.
فالطوارئ لا تعني الخروج على المبادئ الكبرى، أو اختراع مبادئ مستقلة لحالة الطوارئ، وإنما تعني أننا أمام حالة لم تتشكل بعد، تقتضي السرعة في الاستجابة لها، والتقويم المستمر للوضع والعمل على الخروج من حالة الطوارئ نفسها إلى الحالة الطبيعية، فهنا لا نبحث عن تشريع لها؛ بقدر ما نبحث عن استجابة راهنة لها، وعن تحديد شكل الاستجابة الملائمة في زمان وسياق محددين، ريثما نتمكن من تجاوزها للعودة إلى الزمان الطبيعي، وهذا ما يميز فكرة الأخلاقيات التطبيقية عن القانون، ومن هنا فرّقنا بين الطارئ والضروري والطبيعي.
*أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة