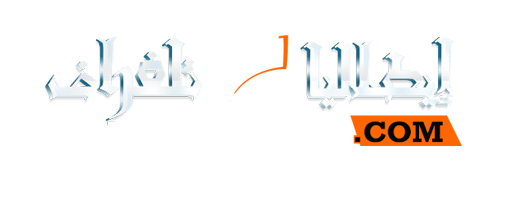حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الدولة القطري، رئيس مكتبة قطر الوطنية.
لا أكتب عن معهد العالم العربي في باريس بصفتي مراقباً من بعيد، بل بصفتي شاهداً على ولادته، ومشاركاً في بلورة فكرته، وأحد السفراء العرب الذين كان لهم شرف العمل من أجله منذ كان مجرّد حلم نتداوله في اجتماعاتنا مع وزراء الخارجية الفرنسيين، إلى أن تحوّل صرحاً ثقافيّاً قائماً في قلب باريس.
كنتُ سفيراً في باريس بين عامي 1979 و1984، في مرحلة شهدت وجود نخبة متميزة من السفراء العرب الكبار، وكان التعاون العربي عبر مجلس السفراء العرب في أوجه. وأعتزّ بأن أكون من الذين ساهموا في الدفع بهذا المشروع الحضاري، إلى جانب شخصيات دبلوماسية عربية رفيعة المقام، منهم: السفراء، السعودي جميل الحجيلان، والمغربي بن عباس، والكويتي عيسى الحمد، والإماراتي سعيد سلمان ثم خليفة المبارك، والسوري يوسف شكور، والتونسي الهادي المبروك، والعراقي محمد المشاط، والأردني طاهر المصري، والسوداني بشير البكري… رحم الله من توفاه الله منهم وأسكنهم فسيح جناته… كان هؤلاء السفراء، وغيرهم، يؤمنون بصدق بأن الثقافة ليست ترفاً دبلوماسيّاً، بل ركيزة أساسية في بناء العلاقات بين الأمم.
في تلك السنوات، تلاقت إرادة عربية جادّة مع توجّه فرنسي واضح لتطوير العلاقات مع العالم العربي، ولا سيّما في بعدها الثقافي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقافة هي الجسر الأعمق والأبقى بين الشعوب. ومن رحم هذا التفاعل، وُلدت فكرة معهد العالم العربي، ووجدت حماساً كبيراً لدى الرئيس فاليري جيسكار ديستان، ثم جاء الرئيس فرانسوا ميتران ليواصل النهج نفسه. وكان وزير خارجيته، كلود شيسون، من أكثر المتحمسين للمشروع، حتى إنه اعتاد أن يلتقي السفراءَ العرب دوريّاً في مكان ريفي خارج باريس، بعيداً عن القيود البروتوكولية، لبحث سبل التعاون الثقافي بصدق وانفتاح. يومها كان الحماس متبادلاً، وكانت الإرادة العربية جماعية، وكان الشعور السائد أننا نؤسس لواجهة حضارية عربية تليق بتاريخنا في قلب أوروبا.
ليس معهد العالم العربي مشروع دولة واحدة، ولا مبادرة ظرفية، بل هو إنجاز حضاري عربي جماعي
اليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود، تثير المقابلة في “العربي الجديد” (21/1/2025) مع المدير العام للمعهد، الشاعر والدبلوماسي، شوقي عبد الأمير، مشاعر فخر ممزوجة بقلق عميق، فالمعهد الذي شاركنا في إطلاقه أصبح منصّة نموذجية للتعريف بالثقافة العربية بوصفها ثقافة حيّة، متعدّدة، ومبدعة، لا مجرّد تراث جامد أو صورة نمطية تختزلها السياسة والأخبار العاجلة. عبر معارض الفن، والموسيقى، والسينما، والندوات الفكرية، وتعليم اللغة العربية، وجائزة الأدب العربي، أدّى المعهد دوراً لا يُقدّر بثمن في تصحيح صورة العرب وبناء جسور التفاهم الحضاري. والأهم أنه نجح، في أحلك لحظات التوتر السياسي وسوء الفهم المتبادل، في أداء وظيفة دبلوماسية ثقافية بالغة الحساسية: تقديم لغة المعرفة والجمال بدل لغة الخوف والصدام. وهذا إنجازٌ حضاريٌّ حقيقي لا يملكه العرب في أوروبا إلا نادراً.
غير أن ما يؤلمني اليوم، وما أخشاه بصدق، أن هذا الصرح الذي وُلد من تعاون عربي– فرنسي متوازن، بات مهدّداً بسبب تراجع الالتزام العربي. فبينما تواصل فرنسا، دولةً ومؤسسات، الوفاء بتعهداتها المالية والسياسية تجاه المعهد إدراكاً لأهميته الرمزية والثقافية، تخلّت دول عربية كثيرة عن التزاماتها الأصلية، باستثناء بعض الدول الخليجية التي ما زالت تحافظ على حدّ أدنى من الدعم.
المفارقة هنا موجعة: العرب يشكون من تشويه صورتهم في الغرب، ومن ضعف حضور ثقافتهم عالميّاً، لكنهم، في الوقت نفسه، يتقاعسون عن دعم أهم مؤسّسة أُنشئت تحديداً لمعالجة هذه المشكلة. أي منطق هذا الذي يطالب بالاعتراف الثقافي من دون الاستثمار في أدواته؟
إنجازٌ حضاريٌّ حقيقي لا يملكه العرب في أوروبا إلا نادراً
ليس معهد العالم العربي مشروع دولة واحدة، ولا مبادرة ظرفية، بل هو إنجاز حضاري عربي جماعي، وأداة استراتيجية للقوة الناعمة كان يفترض أن تحظى بإجماع عربي مستدام، لا بحماسة مؤقتة سرعان ما تخبو. وتراجع العمل العربي المشترك اليوم لا ينعكس فقط على ميزانيّته، بل يهدّد رمزيته نفسها، ويعرّض هذا الإنجاز الثقافي العظيم لخطر التآكل أو التهميش. والخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال تقليص أنشطة المعهد أو إغلاق بعض أقسامه، بل في الرسالة الكارثية التي سيبعثها ذلك إلى العالم: أن العرب لا يقدّرون واجهتهم الثقافية حين تتاح لهم فرصة نادرة لامتلاكها.
من هنا، ليس نداء شوقي عبد الأمير إداريّاً أو ماليّاً فحسب، بل هو نداء حضاري بامتياز. إنه دعوة إلى إعادة التفكير في معنى المسؤولية الثقافية العربية، وفي دور الدول والمؤسسات ورجال الأعمال العرب في حماية مشروعٍ أثبت، على مدى عقود، أنه استثمار في الكرامة الرمزية للعرب قبل أن يكون بنداً في ميزانية.
إذا كان لمعهد العالم العربي أن ينجو ويواصل أداء رسالته النبيلة، فإن إنقاذه يجب ألا يكون منّة من أحد، بل هو واجب جماعيّ
أكتب هذا وأنا أستعيد تلك السنوات التي حلمنا فيها بهذا المعهد، وعملنا من أجله بروح جماعية نادرة، مع زملاء أعزّاء كان بعضهم من خيرة رجالات الدبلوماسية العربية. وأقول بمرارة صادقة: سيكون مؤلماً أن يُترك إنجاز شاركنا في صنعه بأيدينا، ليواجه مصيره وحيداً، في وقتٍ لا تزال فيه فرنسا، بكل جدّية، تحمله أكثر مما يحمله كثير من العرب أنفسهم.
وفي نهاية المطاف، أجد لزاماً عليّ أن أوجّه نداءً صريحاً إلى المملكة العربية السعودية، بصفتها دولة رائدة ذات ثقل سياسي وثقافي في العالمين العربي والإسلامي، وإلى بلدي دولة قطر، بما تمثّله من نموذج مشهود في الاستثمار في الثقافة والدبلوماسية الناعمة: أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للمحافظة على هذا الإنجاز الحضاري، ودعم استمراريّته وتطويره، لا بوصفه مؤسّسة فرنسية– عربية فحسب، بل بوصفه واجهة عربية عالمية تمثّلنا جميعاً.
ليس معهد العالم العربي مجرّد مبنى أو مؤسسة، بل هو نموذج يُحتذى في كيفية التعامل الخلّاق مع الثقافات الأخرى، ومنبر نادر يتيح للعرب أن يقدّموا أنفسهم للعالم عبر الفن والفكر والجمال، لا عبر الأزمات والصراعات. وحمايته اليوم مسؤولية تاريخية، قبل أن تكون التزاماً ماليّاً.
إذا كان لمعهد العالم العربي أن ينجو ويواصل أداء رسالته النبيلة، فإن إنقاذه يجب ألا يكون منّة من أحد، بل هو واجب جماعيّ. فالأمم التي لا تحمي واجهتها الثقافية في العالم لا يحقّ لها أن تشتكي لاحقاً من سوء صورتها فيه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف