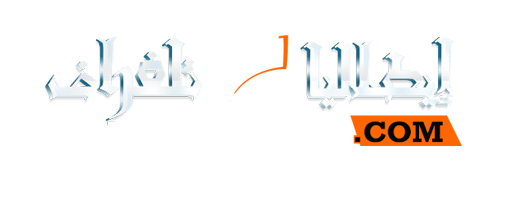أحمد الحجيلي
2026 العام الوليد: عندما تؤجل لذة البداية، ميلاد الغاية
تعد البدايات من أكثر ما يألف إليه الإنسان؛ ففيها لذة مختلفة لا تشبه غيرها، لذة تشبه طعم الانتصار قبل خوض المعركة، وطعم الإنجاز قبل حدوثه. ولهذا ينتظر كثير من الناس العام الجديد، لا لأنه يحمل بالضرورة تغييرا حقيقيا، بل لأنه يمنحهم شعورا بأن أحلامهم ما زالت ممكنة، وأن طموحاتهم لم تغلق بعد.
البدايات بطبعها مائلة إلى ضخ ذلك “الهرمون الخفي” في داخلنا؛ فترتفع نشوة السعادة والإيجابية، وندخل- لدقائق أو لساعات وربما لأيام- في حالة من التفاؤل المؤقت، خصوصا لدى من يتعامل مع العام بوصفه تحديا شخصيا.
كصديق لي لا يسمح لسنة أن تمر دون أن يلتهم أحد تلك المصنفات العتيقة التي تصطف على جدار مكتبته بعناوينها الممتدة وعمقها العريق؛ فهو يرى في كل عام فرصة جديدة، وربما حجة جديدة، ليغوص في ذلك الكنز المكنون. وكذلك تلك الفتاة التي ترى في العام الجديد نافذة أمل للتخلص من أثقال راكمتها الأيام.
العام الجديد يمنح الجميع الشعور ذاته: شعور الفرصة الجديدة. وهو شعور لا يختلف كثيرا عن نشوة الإنسان الذي كان، قبل ثوانٍ معدودة، على وشك أن يهشم تحت عجلات قطار مسرع، ثم نجا. إنها نشوة الحياة التي ولدت من جديد، أو التي ننتظر أن تولد مع أول يوم من العام.
غير أن الارتهان لتاريخ بعينه -أول العام، أو أول الشهر، أو أول الأسبوع، أو رأس الساعة- قد يتحول إلى بوابة خفية للتسويف إن لم يضبط وتره. فكيف نمنع أنفسنا من الوقوع في فخ التأجيل؟ وكيف نحقق ما نصبو إليه دون أن نخدع أنفسنا بلذة البدايات وحدها؟
اللحظة المثالية: العذر الأنيق للتسويف
الحياة لا تنتظر اللحظة المثالية. فوترها المتسارع يجري كلمح البصر، والإنسان المعاصر يعيش حربا مفتوحة مع عدو حسم المعركة قبل أن تبدأ. نعم، أعني ذلك الشبح الذي ما إن تفيق عند الخامسة حتى تكتشف أنه صار التاسعة.
الوقت عدو لا يقهر، ولا يغمد سيفه، سواء حاولت أن تقاتله أم تجاهلته. وكلنا جرب أن يحاول الظفر بيومه كاملا، فلا يخرج في أحسن الأحوال إلا بنصفه. وقد ازدادت شراسة هذا العدو مع التقدم التقني الذي أنعم الله به علينا؛ إذ باتت الشهوة الرقمية -شهوة “السوشيال ميديا”- مصممة بإتقان لتبقينا عائمين فيها أطول وقت ممكن. نغرق في عشر دقائق، ثم نفيق لنكتشف أن ساعة كاملة قد تبخرت.
في هذا الفضاء الرقمي، يختلف الزمن فعلا؛ يتمدد بلا شعور، ويتحول الإنسان إلى رائد فضاء في التسويف، ما لم يكن للتهذيب طريق في حياته، ولضبط الرغبة مكان.
ومن هنا، فاللحظة المثالية التي ننتظرها ليست العام الجديد، ولا رأس الساعة التي تتقابل فيها الأصفار، بل الرغبة الحقيقية في البدء الآن: في تذويب الرواسب الخفية في عقولنا، وفي الكف عن تحويل أعذارنا إلى مكافآت زائفة نشعر من خلالها أننا “سنتغير”، بينما لم يتغير شيء منذ 365 يوما.
كيف نهادن الوقت بدل أن نحاول هزيمته؟
أول ما ينبغي علينا فعله هو تذويب تلك الرواسب عبر المراقبة الواعية لمصادر التسويف كلها: داخليها وخارجيها، وما ينشأ منها عن تشتت أو مبالغة. فبعضنا يتعامل مع ذاته كما لو كانت آلة لا تتعب، يظن أنها ستعمل طوال اليوم بلا توقف. ومن ظن أنه سيهزم الوقت بهذه الطريقة، فليستعد لهزيمة قاسية؛ لأن الوقت- من سنن الله الكونية- ألا يهزم. والظفر فيه لا يكون إلا كمن يغترف الماء بكلتا يديه؛ يشرب بقدر ما استطاع، لا بقدر ما تمنى.
وهناك من يغوص في كل شيء، فيغرق في التشتت، بينما الواجب أن يقسم الإنسان يومه على أولويات واضحة، وفي مقدمتها العبادات؛ فيعطيها حقها ومواضعها. فمن تمام البركة أن يبنى اليوم حولها، لأنها العمود الذي إن قام، صلح معه سائر المقام: من عمل، وهواية، ورياضة. فالجانب الديني في اليوم كالولد البار؛ ما إن تبره في طفولته، إلا برك وأحسن إليك في كبرك.
أما التسويف الخارجي، كالمشتتات بأنواعها، فضبطه وتحديد زمنه يعيدان للإنسان كثيرا من دقائق يومه المتناثرة بين التطبيقات. ويبقى أخطر الأنواع: التسويف الداخلي؛ ذلك العدو الخفي الذي ما إن يتمكن من صاحبه حتى يغرقه في دوامة تفسد عليه يومه كاملا.
ومن التأمل فيه يتبين أنه -في كثير من الأحيان- وليد خطأ ارتكبناه نحن: مبالغة، أو سوء تقدير، أو مثالية مفرطة. ولهذا، فإن الابتعاد عن المثالية في التخطيط ضرورة لا رفاهية. علينا أن نراعي المتغيرات التي لا نملك السيطرة عليها، وأن نسخر يومنا لما هو أولوية الأولويات، لا لمجرد أولويات متفرقة.
ومن الحكمة أن نكافئ أنفسنا بالراحة بعد العمل؛ فإذا منحت خمسين دقيقة من التركيز، فامنح جسدك عشر دقائق يستعيد فيها توازنه. لا تنظر إلى هذه الراحة بعين التسويف، بل بعين “الضريبة” التي لا بد من دفعها كي تستمر عجلة الاستدامة في الدوران. فالمبالغة في الإلزام تقتل الاستمرار؛ لأن النفس لا تحب أصلا الإكراه، فكيف إذا ألزمت بثلاث أو أربع ساعات متواصلة في مهمة واحدة؟ حتى إن نجح ذلك مرة، فإنه ينهار مع أول عارض يقطع الطريق.
البداية الحقيقية
في الختام، لسنا بحاجة إلى عام جديد كي نبدأ، ولا إلى ساعة تتصافح فيها الأصفار. البداية الحقيقية لا تكتب في التقويم، بل تصنع في القرار. فالوقت لن ينتظر، واللحظة المثالية لن تأتي، وما نملكه حقا هو هذه الدقيقة التي بين أيدينا الآن. إن أحسنا استخدامها، بارك لنا في القليل، وإن أسأنا، فلن ينفعنا الكثير.
البدايات جميلة، نعم، لكنها لا تنقذ وحدها. ما ينقذ حقا هو الاستمرار الواعي، ومهادنة الوقت بدل محاولة قهره، والتقدم بخطوات صغيرة لكنها صادقة. فهكذا فقط تتحول لذة البداية من وهم مؤقت إلى حياة متوازنة قابلة للاستدامة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف