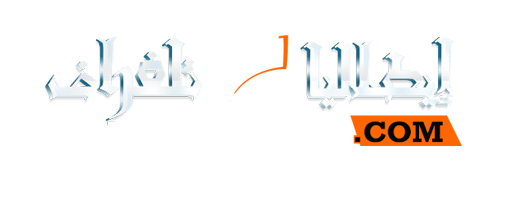سمر يزبك
كاتبة وروائية وإعلامية سورية
لن يشكّل مؤتمر الأقليات في الشرق الأوسط، الذي عُقد أخيراً في إسرائيل، الدولة المصنّفة من الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية دولةً ارتكبت جرائم إبادة، حدثًا مؤسّساً لأي شيء، بقدر ما هو وسيلة إيضاح دالّة على نحو مرعبٍ على انحدار مجتمعات المشرق العربي نحو التفكّك وتحوّل في علاقات الانتماء، فالأقليات، وفق تعريف الدولة الدستوري نفسها، تشكّل المقياس الأدقّ لمدى قدرة الدول على إدارة تنوّعها أو فشلها في ذلك. ومن المهم التذكير دائماً بأن الدولة عندما تعجز عن ترسيخ العدالة والمواطنة المتساوية، تنشأ فراغاتٌ تملأها قوى خارجية بادّعاء “الرعاية” و”الوصاية”، متحولةً من أطراف مراقبة إلى فاعلين يعيدون تشكيل المجال السياسي عبر خطاب الحماية. ولا تشكل إسرائيل حالةً منعزلةً في شرقنا البائس، هناك دول شاركتها وسبقتها في ذلك.
غير أن الخلل الأعمق لا يبدأ من الخارج، ورغم بداهة الأسباب ووضوحها، فإنه لا خيار أمامنا سوى الإعادة؛ فغياب أنظمة عادلة قادرة على استيعاب التنوّع الثقافي والديني هو ما يفتح الباب لتدخّل الآخرين. في سورية، وحتى بعد ما جرى كلّه، لا تزال بنية السلطة السياسية تعمل بمنطق المركز المهيمن والمحيط التابع، بعد حربٍ عمّقت الانقسامات الطائفية والعرقية. الحاجة اليوم إلى إعادة تأسيس الحياة السياسية على المشاركة والمساءلة والاعتراف المتبادل، بحيث تُبنى العدالة على الفعل لا على الهُويَّة. عندها تستعيد الدولة معناها الأخلاقي والسياسي إطاراً يحمي الجميع على قدم المساواة، وليس سلطةً منفصلةً عن المجتمع. إن مواجهة التدخّلات والمؤامرات الخارجية لا ينبغي أن تكون بالشعارات، وإنما بإعادة بناء العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أسس عقدٍ اجتماعي متجدّد يقوم على الاعتراف المتبادل لا على سلطة فوقية. وهذا الدرس تحديداً هو ما فشل فيه النظام السابق، ويعرف السوريون والعالم تماماً نتائج ذلك الفشل.
لكن أن تتصدّر دولة قتلة الأطفال مشهد الدفاع عن الأقليات، رغم سجلّها في التمييز المُمأسس ضدّ أصحاب الأرض الفلسطينيين، حتى من هو حاملٌ منهم لجواز سفرها، فذلك هو المفارقة التي لا يمكن سوى الوقوف عندها. وهي وسيلة إيضاح أخرى، تكشف كيف يُستبدل الفعل الأخلاقي بمجرّد “الخطاب” المنفصل عن حقيقة أن صاحب هذا “الخطاب” يرتكب مجازرَ ما تزال دماء ضحاياها طازجةً تُشاهد في البثّ المباشر يومياً في فلسطين ولبنان وسورية، وحتى اليمن، المجزرة التي رآها وتأكّد منها الأشخاص أنفسهم الذين يبحثون عن حماية أو رعاية لدى آخر احتلالٍ قائم في العالم. الدولة التي تمارس التمييز، حتى ضدّ المجتمعات التي قبلت التجنّد في صفوف جيشها، ولم تحصل (المجتمعات) مقابل ذلك على أيّ اعتراف في قانون القومية الإسرائيلي. إن خطاب “حماية الأقليات المهدّدة” الصادر عن دولة تمارس الإقصاء ليس تضامناً بقدر ما هو إعادة إنتاج للقوة على هيئة أخلاق، لأن الحماية في معناها الجوهري اعترافٌ بالآخر لا سيطرةٌ عليه. أمّا عدم وقوف المشاركين في هذا المؤتمر، ومن يؤيّدهم في مجتمعاتهم، عند هذه المفارقة، فنحيله إلى ما حصل ويحصل من جرائم ومجازر وخطاب كراهية منتشر.
وفي النهاية، لا معنى لتتبّع أسماء المشاركين في مؤتمر كهذا أو تحليل دوافعهم أو البحث عمن يكونون ومن أين ظهروا فجأةً؛ فهُم تفصيلاتٌ ثانوية لا تذكر ضمن مشهدٍ أكبر. التركيز فيهم يمنحهم حضوراً لا يستحقّونه، ويُغفل البنية السياسية التي تسمح بتوظيف الأقليات في لعبة النفوذ. إن تضخيم هذه الأدوار الجزئية يخدم الخطاب الذي يسعى إلى تفكيك المجتمعات من الداخل. وما لم تُبنَ سياسات وطنية جامعة قادرة على احتضان التنوع وحمايته، سيظلّ هذا الفراغ مفتوحاً أمام من يتقن المتاجرة بالأقليات تحت لافتة “الإنسانية” وغيرها، من جرائم لا تزال جارية هنا وهناك.
حماية الأقليات لا تتحقّق بالشعارات، إنما ببناء دولة تُلغي الحاجة إلى “الحماية”، وتبدّد الخوف حين يشعر المواطن (أيّاً كانت لغته أو طائفته) أن القانون يحميه بقدر ما يحمي غيره. عندها تنتفي أسباب الارتهان للخارج ويتحوّل التنوع إلى طاقة خلّاقة. وعندها فقط يصبح الوطن مجالاً مشتركاً للكرامة، وليس ساحةً للصراع على الخوف، وعلى اللهاث وراء “حماية” يوفّرها الاحتلال.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف