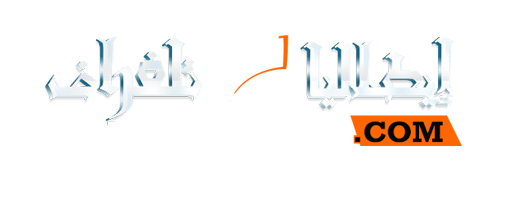محمد أبو رمان
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع.
تعكس تصريحات الملك عبد الله الثاني في مقابلته التلفزيونية مع قناة بي بي سي، 14 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) المنظور الأردني الاستراتيجي في التعامل مع حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، عندما صرّح بوضوح شديد أنّه لا يثق بأيّ كلمة يقولها نتنياهو. وهي تصريحات ذات نبرة حاسمة في تأطير العلاقة بين الأردن وإسرائيل بعد 30 عاماً من معاهدة السلام، وقد سبقت هذا تصريحات شبيهة بتصريحات الملك، لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إذ أصبحت حكومة إسرائيل في الخطاب الرسمي مارقةً ومتطرّفة.
برزت، منذ مرحلة مبكّرة، الخلافات السياسية العميقة بين مطبخ القرار في عمّان ونتنياهو (وتوجهاته السياسية). لكنّ هذه الخلافات وصلت إلى مرحلةً غير مسبوقة، وتطوّرت إلى أن يقود الأردن المعركة الدبلوماسية عربياً ودولياً، منذ “طوفان الأقصى” وحرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزّة، وهو أمر يرتبط بثلاثة أبعاد رئيسة. الأول، التجربة التاريخية الطويلة للسياسات الأردنية مع نتنياهو التي اتسمت بالخصومة. والثاني، الاتجاه الإسرائيلي يميناً، وتزايد دور الحركات الدينية المتطرّفة هناك، التي ترفض فكرة السلام من حيث المبدأ مع الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية، ولا تحمل في جعبتها الفكرية والسياسية إلّا مشروعَ “الترانسفير”. والثالث، عودة ما يسمّى “الخيار الأردني” في دوائر الصهيونية الدينية والسياسية، مع فكرة التهجير القسري وضمّ الضفة الغربية، وعدم توفّر أمل (ولو محدوداً) في وجود تيّار قوي أو موزون في الأوساط الإسرائيلية اليوم، أو حتى في الأمد القريب، يؤمن بضرورة السلام المبني على التسوية السلمية والحقوق الفلسطينية.
تصريحات الملك تعبّر عن نبرة حاسمة في تأطير العلاقة بين الأردن وإسرائيل بعد 30 عاماً من معاهد السلام
وقد عزّزت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبرفقته فريق يميني متطرّف، معضلة التعامل مع المتغيّرات والتطورات الإقليمية، أو بعبارة أدقّ: المحيط الإقليمي والاستراتيجي الجديد، فهنالك تنافس في أوساط الإدارة الأميركية الحالية فيمن يخدم إسرائيل أكثر من غيره، حتى وإن ظهرت خلافاتٌ واضحةٌ بين وزير الخارجية الأميركي الحالي، مايك روبيو (يتبنّى الخطاب الصهيوني بقوة) ونائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس (يميل أكثر إلى جماعة أميركا أولاً)، فإنّها خلافات جزئية لا تؤثّر في دعم الإدارة الأميركية إسرائيل، وهو ما يستغلّه نتنياهو إلى أبعد مدى. والأكثر خطورة من ذلك كلّه، وربّما ما يثير القلق لدى دوائر القرار في عمّان، عودة صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، إلى المشهد السياسي بقوة، وهو المعروف بعدائه الأردن، وكان له (وفق الرواية الرسمية الأردنية) ضلعٌ فيما وصف قبل ستة أعوام تقريباً بقصة “الفتنة”، ويعود الرجل اليوم ليصبح الأكثر تأثيراً في رسم خطط ترامب تجاه غزّة، بل ربما الملفّ الإقليمي بأسره.
من هنا يبدو الأردن حذراً تجاه تطورات الأوضاع في غزّة، فالنقاط العشرون التي أعلنها ترامب لا تعدو أن تكون مبادئ أو أفكاراً عامة، وبالتالي ستكون “معركة التفاصيل” كبيرة ومهمة ومؤثّرة. ولم يستطع الأردن ومجموعة الدول العربية والإسلامية التغيير كثيراً في المسودّة التي عرضها عليهم ترامب، وحملت بصمات كل من ستيف ويتكوف (مبعوثه للشرق الأوسط) وكوشنر ونتنياهو، وكانت الوثيقة متماهية إلى أبعد مدى مع الرؤية الإسرائيلية. لكن القبول بها كان الخيار الاستراتيجي الوحيد لإيقاف الحرب على غزّة، ثمّ تبدأ لاحقاً المعركة السياسية المهمّة في صراع المقاربات الدولية والإقليمية وحرب الأجندات الاستراتيجية، وهي مرحلة ذات طبيعة ضبابية شديدة تصعب فيها رؤية المشهد لمسافة قصيرة، فضلاً عن بناء سياسات واستراتيجيات طويلة المدى للتعامل مع المتغيّرات الجديدة.
ستكون المرحلة المقبلة مليئة بالتحدّيات (بالنسبة إلى الأردن والفلسطينيين) على صعيد الأسئلة المتعلّقة بمستقبل غزّة. وهنالك خلافات جوهرية في وجهات النظر بين الأردن والمجموعة العربية الإسلامية من جهة، وإسرائيل والإدارة الأميركية من جهةٍ أخرى، حول معظم الملفّات في المرحلة الثانية: بنية اللجنة التكنوقراطية الإدارية (ترفض إسرائيل الأطروحات الفلسطينية والعربية)، ودور مجلس السلام العالمي (يرفض الفلسطينيون الوصاية الأميركية ويريدون تحديد دوره في البُعد الإنمائي والإعماري)، ودور القوات الدولية (يصرّ الأردن على أن دورها حفظ السلام والفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، وألا يكون دورها داخلياً، بينما يترك الدور الداخلي للشرطة الفلسطينية التي تُدرّب في مصر والأردن)، وعلاقة اللجنة التكنوقراطية بالسلطة الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي من غزّة، وتعريف سلاح حركة حماس، ولمَن تسلّمه (يدرك الأردن أن إسرائيل تركّز في شبكة الأنفاق وتريد إنهاءها بالكامل)… وهكذا، الملفّات العالقة والمفتوحة كثيرة وعديدة، وتشكّل بحدّ ذاتها معركة أخرى.
تتجنّب المقاربة الأردنية تجاه غزّة المزاحمة مع كل من مصر وقطر وتركيا، والأولويات الأردنية هناك تتمثّل بوقف الحرب، والجانبين، الإغاثي والإنساني، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، بينما الوساطة والنفوذ السياسي متروكان لهذه الدول. لكن الوضع في الضفة الغربية مختلفٌ تماماً، فهي جزءٌ من منظور الأمن القومي الأردني، تثير القلق الشديد لصانع القرار في عمّان، وقد كان للأردن دور كبير في إقناع الرئيس ترامب بإعلان رفض ضمّ الضفة الغربية. لكن هنالك هواجس أردنية من أنّ هذا الرفض رخو وهشّ، ولا يعني بالضرورة الديمومة من زاوية، أو رفض ضمّ الأجزاء كلّها في الضفة، فقد تبدأ إسرائيل بها واحداً تلو الآخر، فضلاً عن أنّ الضمّ عملياً مشروع قائم على قدم وساق؛ وينهي أيّ كينونة سياسية فلسطينية.
يركّز الخطاب الدبلوماسي الأردني في أنّ هنالك حرباً صامتة دائرة في الضفة الغربية بالتزامن والتوازي مع الحرب القائمة في غزّة، وأنّ مشروع الضفة بالنسبة إلى المتطرّفين الصهاينة في الضفة والقدس أشدّ خطورةً على الأمن الإقليمي، وأكثر تأثيراً في تفجير المنطقة، والخطر كلّه في انهيار السلطة الفلسطينية، وفي الفراغ الأمني، وفي المشروع الإسرائيلي في تحويل الضفة “كانتونات” معزولة تحت ظروف اقتصادية قهرية، وفي “ترانسفير” اختياري سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
لا تقتصر مشكلات الأردن مع الجار الخطير (حكومة نتنياهو) في الجانب الغربي، بل تزداد خطورة سياساته في الجانب الشمالي من الحدود، بخاصة في ما يتعلّق بالسويداء والمناطق الجنوبية في سورية، إذ من الواضح أنّ هنالك أجندة إسرائيلية فاعلة لتقسيم سورية وترسيم خطوط جديدة للنفوذ هناك، وجعل النظام السوري الجديد تحت رحمة حكومة نتنياهو، بالسيطرة على بؤر استراتيجية في الجنوب، وربط السويداء بالجولان، وضمان وجود عسكري وأمني إسرائيلي في جنوب سورية، باستثمار شخصيات حولها علامات استفهام كبيرة مثل حكمت الهجري. وفي حال كان هنالك محاولة إسرائيلية لإيجاد معادلة جيوسياسية في الجنوب السوري، فسيكون الأردن أمام تحدٍّ كبير وحقيقي، وربّما يدفعه إلى تغيير مقاربته العسكرية والأمنية في التعامل مع الحدود الشمالية.
“نشطت الدبلوماسية الأردنية لتشكيل شبكة تحالفات استراتيجية تواجه حالة عدم اليقين الأميركي
في ضوء ذلك، يبرز تحدٍّ آخر في التعامل مع السياسات الأميركية، ومع شخصية مثل شخصية الرئيس ترامب، بخاصة أنّ هذه الإدارة من الواضح أنّها (كما أكّد مسؤول سابق فيها في جلسة مغلقة في معهد السياسة والمجتمع في عمّان قبل عامَين) تقلّل من القيمة الاستراتيجية للأردن؛ فترامب يركّز في الدول الإقليمية الكبيرة، وفي مَن يملكون الثروات، ما يجعل الأردن حذراً متيقّظاً في التعامل مع هذه الإدارة. وبالرغم من تجنّب الأردن محاولة الاصطدام بها، ستقول عمّان لواشنطن: لا، بوضوح، في لحظة معينة قد تستدعي ذلك، وهو ما حدث سابقاً في حقبة ترامب الأولى، بل منعطفات تاريخية عديدة شبيهة.
الرهانات الأردنية اليوم على تشكّل محورٍ استراتيجي إقليمي جديد يسمّى “المجموعة العربية الإسلامية” تأخذ مواقف مشتركة ومشابهة للأردن. وتبدو علاقات الأردن بكل من السعودية وقطر في تحسن مطّرد واضح، وتوافق في الملفّات الاستراتيجية الإقليمية، وكذلك الحال في علاقته التقليدية بالإمارات ومصر، وهنالك رعاية أردنية كاملة للنظام السوري الجديد، وقناعة في عمّان بأنّ البديل عنه ستكون الفوضى والحرب الداخلية، كما تتحسّن العلاقات الأردنية بصورة جلية مع تركيا.
على صعيد العلاقات الدولية، نشطت الدبلوماسية الأردنية بصورة غير مسبوقة، خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحسّنت بشدّة علاقة الأردن بأوروبا، وتحتفظ عمّان بعلاقات جيدة مع الروس، وسيقوم الملك الأسبوع المقبل بجولة سياسية في دول آسيوية صديقة، وهي خطوات تأتي لتطوير العلاقات الأردنية الدولية والإقليمية، وتشكيل شبكة من التحالفات الاستراتيجية مع هذه الدول للتعامل مع حالة عدم اليقين التي تغلّف تماماً العلاقات الأردنية الأميركية، وتطوّر الأزمة المفتوحة وتعمّقها مع الواقع الإسرائيلي الجديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف