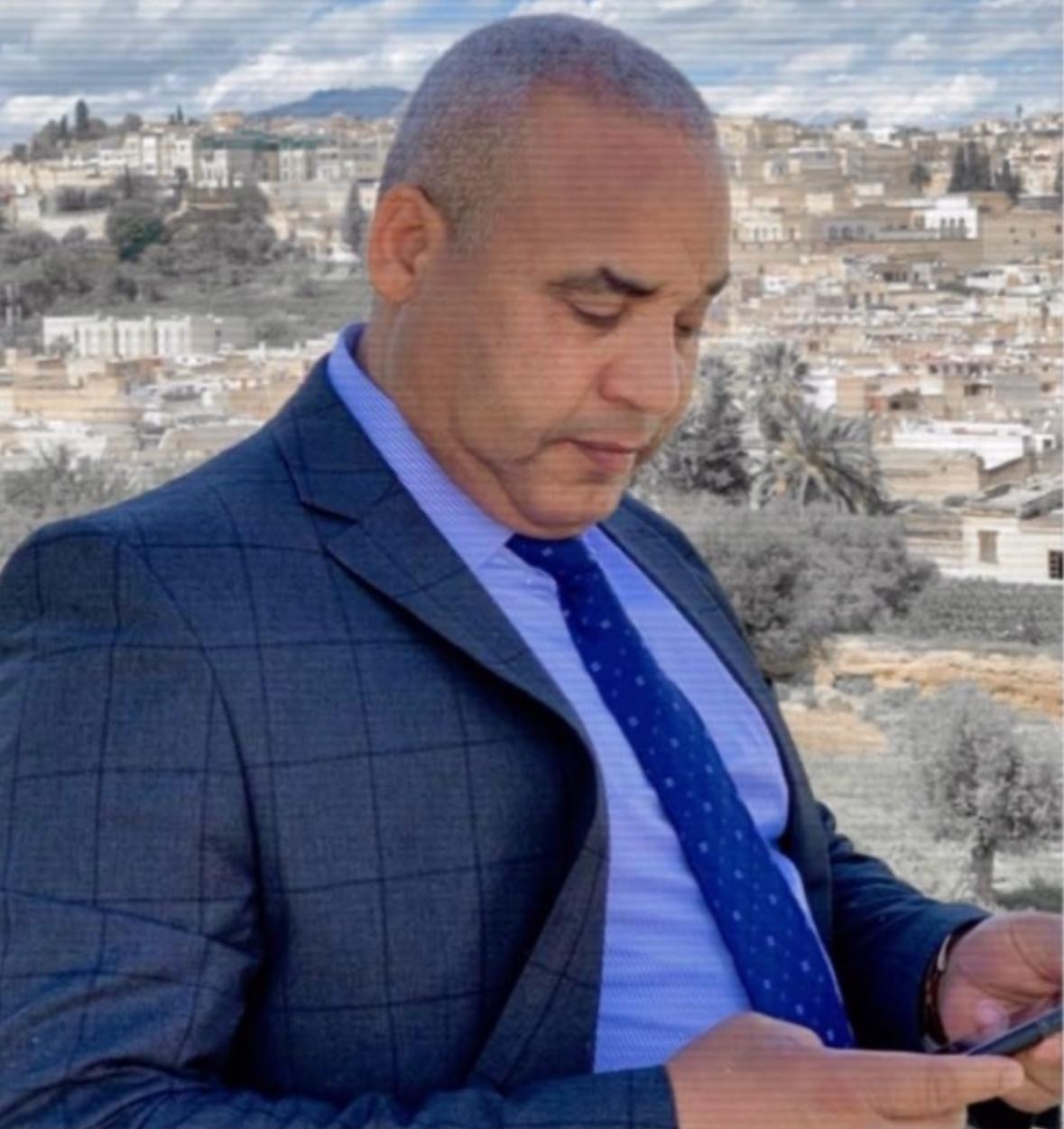ثقافة التّنحِّي والاستقالة والاعتراف بفداحة الخطأ أو الغلط لَمّا تترسّخ بعد عندنا..!
* الدُّكتور عبدالله شنفار
الكاتب والمفكر المغربي.
سنة 2004، وأنا أتابع بعض جلسات مُحاكمة الرّاحِل صدّام حسين ومن معه، والتي كان يُسمح بنقل أطوار جلساتها على المباشر عبر قناة الجزيرة القطريّة الفضائيّة؛ كان من بين التُّهم الخطيرة جداً التي وُجِّهَت إليهم، بعيداً عن قضية الدّجيْل، وقضية الأنفال، ومسألة غزو الكويت، وقتل معارضين سياسيين، وقمع الانتفاضات الشعبية، وتهجير وتدمير القرى، واستخدام الأسلحة الكيميائية، واضطهاد الطائفة الشيعية، وغيرها من التُّهم التي مارسها قيادات وأتباع حزب البعث؛ هي تُهمة: “تعريض البلد إلى احتلال أجنبي”..! وهي تهمة لوحدها كافيّةً لإصدار حكم الإعدام في حقه ومن معه، لتحقيق نوع من الردع العام والخاص، وجعله عِبرة لمن يعتبر؛ لكل من يهدد أو يُساهم، بتهور غير محسوب، سلامة وأمن ومقومات الدولة الأمّة القائمة على أسس وركائز أساسيّة، وهي: الوُجود؛ والسِّيادة؛ والاستمرار؛ والاستقرار؛ والتنميّة والعمران والإعمار.
وبالتّالي؛ فإن ثقافة التّنحِّي وتقديم الاستقالة والاعتراف بفداحة الخطأ أو الغلط لَمْ تترسّخ بعد عندنا في ثقافتنا العربيّة والإسلامية.
والمشكلة لا تكمن فقط في صعوبة إيجاد مقترحات الحلول والبديل؛ للمشاكل والقضايا المطروحة؛ ولكن المشكل يكمن في نقطة عدم الاعتراف بفداحة الخلل؛ الذي يبقى من الصعب الوصول إليه؛ نظرًا لتكثيف وتضخيم في شبكة العلاقات؛ مما يفضي إلى تبني ظاهرة الوثوقية واليقينية لدى صاحبه!
عندما تكون الطريقة والمنهج المتبع في حل مشكل ما ضعيفة وضئيلة؛ فهي تُشبه إلى حد ما؛ القياس بمسطرة مُعَوَّجَّة؛ تعطيك قراءات متعددة لقياسات خاطئة لنفس الحالة!
لكن الخطير في الأمر؛ هو لمَّا يتشبث البعض بسلامة المسطرة رغم اعوجاجها؛ ويبحث عن عشرات الطرق والأساليب الملتويّة؛ ليبرر تلك القراءات الخاطئة.
يبدو أن هؤلاء قد تناسوا وتجاهلوا الحِكمة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا﴾. (وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) واستأنسوا في حواراتهم مع الناس؛ ادعاء امتلاك الطبعة الأصلية للحقيقة؛ والخوض في الجدالات العقيمة التي زُرعت في تربة الجهل؛ وسقيت بماء الظنون.
إن التفكير المنهجي السليم؛ هو طريقة تحليل وتقييم لجميع الأجزاء المترابطة فيما بينها؛ في إطار نسق أو نظام معين؛ والتي بدورها تشكل موقفًا حتى تحقيق وعي أكبر بالأحداث والوقائع.
فالجهاز المفاهيمي والمعرفي لقضايا والمشاكل المطروحة، كبنية عند هؤلاء المنغلقة على الذات؛ صُمِّمت لحماية نفسها؛ من خلال نهج أسلوب الوثوقية الزائدة واليقينية المطلقة؛ مما ينتج عنه أفرادًا لا يفكرون سوى به؛ فقط؛ ولا ليتفكروا فيه أبدًا.
لما تنادي بإحداث التغيير؛ والقوة الصلبة ترفضك وليست معك، ولن تكون في يوم من الأيام معك؛ ولا حتى المواطنات والمواطنين، هم إلى جانبك؛ و95 ٪ من دول العالم لا تساندك؛ فكيف يكون لك وجود داخل المنتظم الدولي وأنت تعاني الحصار الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي؟ هذا أقل ما يمكن أن يقال عنه: إنه انتحار ومجرد شعار أجوف.
صاحب الخطاب السياسي المبني على معطيات الواقع؛ يكون له التزام؛ وعندما لا يستطيع تغيير الواقع؛ فإنه يعمل على إحداث تعديلات وإدخال تغييرات على شروط إنتاج واستمرار هذا الوضع أو الواقع؛ من خلال دراسة معمقة حول الممكن والغير الممكن؛ المنطقي والغير منطقي؛ المُتاح والغير متاح من الجيوش واللوجستيك والمعدات وحتى التوقيت والمكان والمناخ الداخلي والخارجي والدولي والعالمي… وغيرها. أما صاحب الخطاب العاطفي؛ فمسكين له أنماط تفكير بالتمني بأن معجزة ما، ستحدث يومًا ما، وتغير مسار حياته وتحدث تحولات في مجريات الصيرورة التاريخية.
والخلاصة هي أن اللسان لا يوقفه شيء؛ إلا سعة الإمكانات.
في المجتمعات الحديثة؛ هناك حرب أفكار مستدامة. وعندما نخاطب عقولًا وأفكارًا؛ فنحن نصنع بذلك الرأي العام؛ من خلال محاولة إحداث تغييرات وتأثيرات عميقة فيه. وبالتالي لكي ننجح في إيصال فكرة معينة؛ لابد من معرفة شيفرات المتلقي أو من نخاطب. هذه الشِّفرات تتغير باستمرار من حال إلى حال؛ وفيها الثابت الذي لا يتحول ولا يتغير وفي حالة جمود.
الأمر اذن يتطلب ذكاء وقدرات لمعرفة قوانين التحول الاجتماعي؛ التي هي عبارة عن فضاءات ومساحات ملغومة ومزروعة بالعديد من الأفكار والقيم والألغام السابقة من مختلف القناعات والمصالح المتناقضة؛ الاجتماعية والسياسية والمالية والاقتصادية والشخصية والعسكرية والإستراتيجية… وغيرها؛ منها الضارة ومنها النافعة؛ ومنها الإيجابية ومنها السلبية.
ومن هذه القوانين والمعايير والمؤشرات؛ والأبعاد المتواجدة في عقول البشر؛ هي إدراك مدى القابلية للأفكار المطروحة ومعرفة مدى عناصر المقاومة وردود فعل الحرس الموجود؛ واستيعاب كل تلك المتناقضات الاجتماعية. وبالتالي كل خلل في الخطاب والتواصل وفهم الواقع الدولي والمحيط العالمي؛ سوف يؤدي حتماً إلى نتيجة عكسية.
معرفة شِفرات هذه الذاكرة المشوشة والتي تعيش حالة شك وريب وارتباك أو حالة جمود وركود وأفكار ميتة؛ يتطلب القدرة على التواصل؛ من خلال عملية انتقاء المعلومات ودراستها بدقة؛ لمعرفة من ستقاوم ومن ستقتنع بسهولة ومن يسهل تغييرها؛ مع إخضاعها للتقويم والتتبع والتجاوز لخلق فضاء مفتوح قابل للتطور.
* التذرع بتبرير: لم نكن نتوقع؛ هو ما الذي لم يكن يتوقعه!؟
حينما تكون الأحداث والوقائع بارزة وواضحة وضوح الشمس في النهار؛ فيشيح عنها النظر ويغض عنها الطرف؛ ويأتي في الأخير ويقول: “لم نكن نتوقع”!
لم نكن نتوقع حجم المؤامرة العالمية! والكراهية الدولية! وحجم التخطيط العالمي!
حينما تكون شعوب وأمم مسكونة بفكر المؤامرة؛ تكون دائمًا غير قادرة على الاستنبات والاستنتاج والاعتبار من الابتلاءات والمصائب.
مجتمعات مسكونة بالشك والخوف؛ ليس لها القدرة على تكوين صورة حول تدفق الأحداث والوقائع والأفكار على جميع المستويات؛ سواء التحولات الداخلية؛ أو التغيرات العالمية.