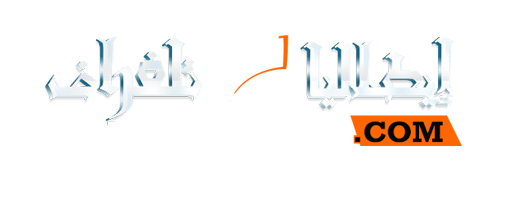* الدُّكتور عَبْدُ اللَّه شَنْفار
في بعض الجغرافيات السياسيّة، لا يُختار “العدو” لأنه خطر أو خصم أو عدو حقيقي أو محتمل؛ بل لأنه ضرورة نفسيّة للنظام.
المغرب، في هذا السياق العام، لم يكن خصمًا او عدوّاً طبيعيًا محتملاً، بل تحوّل إلى “آخر ضروري”: وكيان يجب أن يبقى قائمًا فقط ليُشار إليه، ويُستحضَر ويستدعى كلما ضاقت الأسئلة داخل البيت.
لم يُعادَ المغرب لأنه حگر – احتقر أحداً- ولا لأنه اعتدى أو ظلم، ولا لأنه هدّد؛ بل لأنه استمر واقفًا. ولأن وجوده الآمن والمستقر والقديم والصامت، كان كافيًا ليُذكّر أن الخلل ليس في الجغرافيا… بل في المرآة.
كلما تأزّم وتعثّر الداخل، أُشير إلى الخارج. وكلما جفّ المعنى، استُحضِر العدو. وكلما اهتزّت شرعيّة النظام والخطاب، كان المغرب حاضرًا كذريعة وشمّاعة جاهزة، لا لتفسير الأزمة الداخليّة، بل لتأجيل الاعتراف بها.
هنا يصبح العداء وظيفة سياسيّة، لا موقفًا سياديًا. وطقسًا يُمارَس بانتظام، لا لأن المغرب خطر محتمل، بل لأن غيابه عن المشهد سيترك فراغًا قاتلًا: فراغ السؤال الحقيقي… لماذا فشلنا ونجح المَرُّوك؟
المؤلم في هذا العداء، أنه ليس صدام ندّين، بل قطيعة مع ذاكرة مشتركة ومع دمٍ واحد ولسانٍ واحد وتاريخٍ مشترك، كان يمكن أن يكون سندًا لا سكينًا.
ومع ذلك، اختير المغرب ليكون الجُرح، لا الشريك؛ الشاهد، لا الرفيق. وهنا تستعيد السياسة معناها الشعبي العميق، كما قال المغاربة قديمًا وحديثاً: “قطع الواد ونشفو رجليه.”
عبروا على استقرار المغرب وانتفعوا من مساعدته ودعمه وتوازنه واحتموا بجغرافيته الرمزيّة، ثم، بعد العبور… أنكروا الماء، وجفّفوا المنبع، كأن الذاكرة يمكن محوها، وكأن التاريخ لا يعود ليطالب بثمنه.
ليست المرارة في الخصومة، بل في أن يتحوّل القرب إلى إنكار، والتشابه إلى حقد وكراهيّة، والنجاة المشتركة إلى رواية عداوة مُصطنعة.
أن تبلغ الكراهية حدّ التشفّي في الكارثة، وأن يُستدعى الإله لتبرير الألم، فذلك ليس موقفًا سياسيًا، بل إفلاس أخلاقي كامل.
فحين يُقال، ببرود شماتة: “لقد أرسل الله سيل العرم على المروك”، نكون أمام انكسار عميق في المعنى، لا في الخطاب فقط.
الكارثة الطبيعية، في كل الثقافات، امتحان للضمير قبل أن تكون حدثًا جغرافيًا. ومن يرى في الفيضانات عقابًا موجّهًا لجارٍ بعينه، لا يكشف عن قوّة إيمان، بل عن عجز داخلي يبحث عن عزاءٍ في مصائب الآخرين.
ذلك القول لا يفضح المغرب، بل يفضح قائله. يفضح نظامًا رمزيًا لم يعد قادرًا على إنتاج أمل، ولا على مواجهة أزماته، فاستعار لغة الغيب ليغطي بها خواء الواقع. وحين تُستدعى السماء لتصفية حسابات أرضية، نكون قد تجاوزنا السياسة إلى تشويه المقدّس نفسه.
الخطير هنا ليس الشتيمة، بل التشفي.
ليس العداء، بل الفرح بالخراب. فالتشفّي علامة واضحة على أن الخصومة لم تعد حول مصالح أو حدود، بل حول حقدٍ بلا مشروع.
وهذا هو المؤشر الأخطر على ما بلغه جار السوء من إفلاس: أن يعجز عن الفرح بنجاة البشر، وأن يجد في ألم الآخرين لحظة انتصار وهمي، وأن يعتقد أن الخراب الإلهي يُصيب دائمًا غيره.
في تلك اللحظة، لا يعود الجار خصمًا،
بل يصبح أسير مرارته، محاصرًا بخطاب لا يبني، ولا يُصلح، ولا يداوي… خطاب لا يعرف من السياسة سوى الشماتة، ولا من الدين سوى التوظيف الرخيص.
أن يُستغلّ ابتلاء الكارثة الطبيعيّة، لا لمدّ يد العون أو حفظ الحدّ الأدنى من الود والكرامة الإنسانيّة، بل لاستفزاز شعبٍ منكوب عبر العبث بترسيم الحدود على الواجهة الشرقية، فذلك ليس خطأً دبلوماسيًا عابرًا، بل قمّة الوقاحة السياسية وامتهان سافر لكل ما تبقّى من أخلاق الجوار.
حين تتحوّل لحظة الألم إلى فرصة نكاية، وتُستدعى الخرائط في وقت الدموع، نكون أمام ركوبٍ واعٍ للدناءة، لا يهدف إلى تثبيت سيادة ولا إلى حماية حدود، بل إلى جرّ المنطقة قسرًا نحو حافة صراع لا يعرف أحد كيف ينتهي ولا من سيدفع كلفته البشرية.
هذا السلوك لا يعبّر عن قوة، بل عن طيشٍ محسوب بسوء نية. ولا يدلّ على ثقة في الذات، بل على رغبة مَرَضية في اختبار صبر الآخرين وهم مثخنون بالجراح. فالذي يلوّح بالحدود في زمن الكارثة، لا يحمي وطنًا، بل يلعب بالنار فوق أنقاض البيوت.
الأخطر من الاستفزاز ذاته، هو توقيته: توقيت يفضح عقلًا سياسيًا يرى في المعاناة الإنسانية مادة للمساومة، وفي الخراب فرصة للابتزاز، وفي الجغرافيا سلاحًا يُشهر حين يعجز الخطاب عن الإقناع.
بهذا المعنى، لا يعود الأمر خلافًا حدوديًا،
بل انحدارًا أخلاقيًا مكتمل الأركان: تديينٌ للشماتة، وتسييسٌ للكارثة، وتوريطٌ متعمّد لمنطقة بأكملها في مغامرة لا عاقل يدعو إليها.
إنها لحظة يُقاس فيها معدن الدول لا بخطاباتها، بل بما تفعله حين يسقط الجار.
ومن يختار الاستفزاز في زمن الانكسار، لا يسيء إلى غيره فقط، بل يوقّع بنفسه على شهادة إفلاسٍ أخلاقي لا تمحوها الخرائط ولا تبرّرها الشعارات.
نهمس في أذنهم: المغرب دولة غير قابلة للاحتواء السهل، ولا يساوم على ثوابته، ولا يروّج لنفسه بالضجيج، ويملك عمقًا تاريخيًا كدولة قديمة.
بعض الدويلات الحديثة تاريخيًا ترى في ذلك تفوقًا رمزيًا مزعجًا، فيتحول ذلك إلى حساسيّة سياسيّة مفرطة. والدول التي تزعجها هذه الصفات، تُسمي انزعاجها مواقف سياسيّة.
ذلك هو المغرب حين يُختزل في دور “الآخر الضروري”: ليس لأنه خطر… بل لأنه المرآة التي لا يريد البعض أن ينظر فيها.
*نبذة موجزة حول الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه؛
مفكّر وباحث مغربي متخصّص في العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وناشط في الرصد والتحليل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي.
له عدة إسهامات فكريّة ومقالات تحليليّة ترصد التحوّلات المجتمعيّة وتقدّم قراءات نقديّة للتحديات الراهنة في المغرب والعالم العربي والإسلامي، من أبرز مؤلفاته: الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية (2000). الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة (2015)، والفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة (2020).